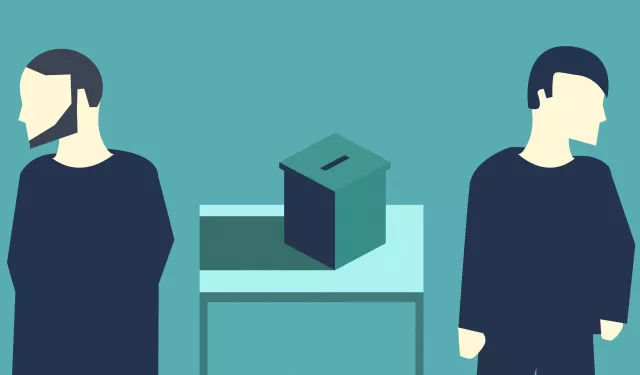
ديموقراطية رقمية: حلمًا بناخب أقل حساسية لأحمد موسى
من فضلك، ورط شعورك كما تورط عقلك، واحلم*.
فلاش باك أول
الثامن والعشرون من يناير/كانون الثاني 2011، شبين الكوم، المنوفية.
خرجت المظاهرات بكثافة في القاهرة منذ أيام؛ الجميع متأهب لدعوات النزول اليوم الجمعة في المحافظات للتأكيد على الثورة الشعبية. حضَّرنا أنفسنا، وحشدنا من الأصدقاء والمعارف من ظنناه مهتمًا بالتفاعل مع الحدث، كانت عائلتي قد عرفت بشأن اهتمامي بالنشاط السياسي لمّا احتجزت من جهة الأمن قبل شهرين أثناء جمع توقيعات لتغيير مواد دستورية.
أبي بدافع الخوف عليَّ يحاول بكل الطرق منعي من المشاركة، ولمّا فشلت محاولات إقناعي، أعلن عدم رضاه غاضبًا كسلاح أخير لاستثارة شعوري بالذنب، لكن الحدث كان أكبر من الجميع، وإن كان عدم رضا أبي الثمن فلا بأس.
تمر الساعات عليَّ ضمن المتظاهرين في الشوارع، والصوت المتشائم داخلنا، الذي توقعه يومًا لتكسير عظام الأعداد القليلة التي ستتفاعل مع الحدث في مدينة معروفة بميلها السلطوي المحافظ، يخفت تدريجيًا إلى أن يخرس تماما تحت وقع هتاف الآلاف من المتظاهرين.
بطل أنا؟ ليس تمامًا. لأن بطولة هذه الفقرة هي في الحقيقة لأبي؛ تلقيتُ اتصالًا من أمي حوالي الرابعة مساءً (كانت الاتصالات تعمل في المنوفية) لتخبرني أن أبي قبض عليه في المظاهرات وهو الآن محتجز في قسم الشرطة. أبي الذي لا يذهب إلى الانتخابات بحجة عدم الجدوى، ذو المزاج المحافظ، الذي كان لتوه رافضًا مشاركتي، ينزل للتظاهر ويقبض عليه؟
حسنًا سيخرج أبي بعد بضع ساعات، ولن يشارك فيما تبقى من أحداث الثورة، سيصوت للإسلاميين في انتخابات برلمان 2011، ثم يعود لمقاعد العازفين عن المشاركة فيما تلى، لكن ألا تستحق تلك اللحظة الثورية بتناقضاتها وكثافة وتعقيد مشاعرها بين الخوف والأمل، الشجاعة والمخاطرة، أن تنتبه إليها العملية الديمقراطية؟
فلاش باك ثان
الرابع عشر من أغسطس/آب 2013، شبين الكوم، المنوفية.
وقف أحدهم على طاولة وسط مقهى ورقص، يبدو أنه أحد الذين فوضوا السيسي قبل أسابيع لسفلتة المعتصمين بالدبابات، المدينة صغيرة نسبيا ووجه الرجل مألوف، أتذكر رؤيته في مسيرات متعددة خلال يناير 2011، أغض الطرف عنه وأمشي إلى البيت، مرجعًا شعوري بالإنهاك في ذلك الصباح إلى ورديتي الليلة الطويلة في العمل، متسائلًا إن كان للحسنة أن تعادل السيئة في كون مواز، هل يكون تفويضه لاغيًا؟
أتأمل السؤال نفسه كنوع من السذاجة التي تعد بجوهر خيّرٍ في البشر، ثم أحلم بنموذج إحصائي ما، تُمنح العداوة والكراهية مكانًا فيه جنبًا إلى جنب مع قيم أخرى أقل حسمًا في شرها، فتمنعها من الاستئثار ببقعة الضوء.
فلاش باك ثالث
الرابع والعشرين من يناير 2015، القاهرة، مصر.
العالم كما نعرفه يتغير، التظاهر في الشارع صار انتحارًا، لحظة صعود درامية للديكتاتورية العسكرية قادمة من ثلاثينيات القرن العشرين، ولا سبيل للقلة المعترضة على قتل المتظاهرين في الشوارع سوى النحيب والصراخ في الفضاء الافتراضي؛ صراخ سيتبلور بعد قليل في نبرة انهزامية مبررة، إلى أن تأتي الذكرى الرابعة للثورة فتقتل شيماء الصباغ بالقرب من ميدان التحرير، الدم نافر من عنقها وفي يدها تحمل وردة، في مشهد لو أنه كُتب في رواية لتحسسنا من مبالغته في رومانسيته.
يتزامن مع تلك الهزائم العامة، هزائم شخصية، وواقعة احتجاز أخرى مذلة، وتشخيص طبي بالاكتئاب، انسحبت على إثره من أي نشاط في المجال العام، متخذًا موقعًا إلي جوار أبي على الكنبة نفسها، آكل نصوصًا مثل The depressed person لديفيد فوستر والاس، وأفلام مثل حصان تورينو لبيلاتار. أتساءل عما يمكن فعله في أوقات كتلك وأفكر بسمت المنهك من التعب وسذاجة العاجز؛ هل يأتي يوم تستوعب فيه الآليات التصويتية لحظة مثل تلك كثيفة في مشاعرها وطاقة غضبها لتُبصق في وجه الشبح المظلم للدولة المصرية؟
اقرأ أيضًا: بلال لأمه شيماء الصباغ في ذكراها الخامسة: أحبك كثيرًا و"لما أكبر هبقى يوتيوبر"
ربما تشاركنا أنا وأبي في هذه اللحظة، برغم اختلافاتنا الكبيرة في الأفكار، عزوفنا عن المشاركة في أي انتخابات رسمية، وربما سيعتبر الخطاب المهووس بالتفاعل والمشاركة كفعل إيجابي مطلق، أننا رجلان سلبيان اختارا أن يكونا هامشيان بإرادتهما، وعليهما أن يتحملا نتائج اختيارهما عندما ينتج لهما الصندوق ديكتاتورا عسكريا بمباركة شعبية كاسحة. لكن ألا يمكن أن يكون الشكل الحالي للممارسة الديمقراطية تحديدًا في عمليات التصويت والانتخاب (بافتراض نزاهتها) هو الشكل الاختزالي والمبسط لموقف أبي ومشاعره المتراكبة والمعقدة التي تجلت في لحظة نزوله للشارع في 2011؟ ومشاعري المتراكبة التي تجلت في لحظة انسحابي منه لاحقًا؟
فلاش باك رابع
العالم في 2016. سوريا تحت نيران بشار الأسد، ولاجئون يغرقون في المتوسط. حدود تغلق من كل اتجاه في أوروبا، وبريطانيا تصوت "نعم" للبريكست. ترامب يُنتخب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة وأحزاب اليمين المتطرف تصبح أكثر شعبية في أنحاء العالم. الجنون إذًا ليس في مصر وحدها، وليس في الدكتاتوريات وحدها. هناك غضب عام يخرج عشوائيًا في كل اتجاه. ليكون هذا السؤال صالحًا: لأي مدى تستطيع أدوات الديمقراطية التمثيلية استيعاب غضب الجموع؟
عودة إلى الحاضر
نحن الآن في 2041. بعد أسبوعين سينعقد استفتاء يسأل الناس عن مستقبل الديموقراطية التمثيلية وبدائلها. أفاتاري ينسخ صوتي، ويقول:
"الديمقراطية التمثيلية ما بقتش كافية لتحقيق غرضها. ناهيك عن أنها ديمقراطية بالوكالة وكأنك مواطن فاقد الأهلية، فهي كمان في معظم الأحيان اختزالية، مختصرة في خياري نعم ولأ. تطلب من المواطن اختصار موقفه من كل ما هو سياسي بوضع علامة (الصح) على ورقة كل كام سنة، وتنتقل الشمولية من كونها توجه بتمارسه الدولة في الدكتاتوريات إلى ممارسة بتنبثق عن الفرد نفسه، بيتم توجيه الفرد فيها للتفكير في نفسه ككتلة ذات بُعد واحد، باستخدام أدوات زي الضبط الممنهج والمحرمات اللي بتكرسها السلطة بالبروباجندا والتخويف واستنفار صوت من الرقابة الذاتية بيحضر مركزيا في عقل الناخب وهو رايح للتصويت. وحتى وإن فلت الناس من كل تلك الفخاخ تظل الآليات الحالية في معظم أشكالها بتلعب لعبة الـ50٪ +1 وبتتجاهل تمثيل قطاعات واسعة من الناخبين. كذلك فحتى أكثر البلاد شفافية وإن تمكنت من تحييد تلك العوامل، تظل الآلية نفسها في جوهرها متجاهلة تجزؤ وتعقد الأفكار والمواقف السياسية وتبدلها على الدوام.
لذلك أنا برفض الاتهام السهل للمصوتين لليمين بكافة أشكاله بنقص الوعي. صحيح إنه نسبة مؤيدي اليمين من متوسطي التعليم أكبر منها بالنسبة للحاصلين على تعليم أفضل، لكن طول الوقت في أسباب عميقة ومنطقية ورا تأييدهم ده. أسباب تتعلق أيضا بالمال السياسي والكفر بمؤسساتية مستغلة أكثر منها محررة، وعدم الرضا عن الطبيعة التنافسية الطاحنة لنظام العمل، وقلة الفرص وشح السكن وغيرها من الأسباب اللي بتخليني في المقابل أرد الخلل لسؤال التصويت المعتل في ذاته، اللي لكونه اختزاليًا بتتلاعب بيه كامبردج أنالاتيكا وفلوس اليمين الجمهوري، وبيتلاعب بيه أحمد موسى عندنا".
أحد المرشحين لاستبدال نموذج نعم/لأ الحالي، هو نظام تشغيل (OS) لباحث اسمه سيزار هيدالجو، فاز قبل ذلك بالانتخابات التي أجريت في الكون الافتراضي الذي قام هيدالجو وفريقه بتطويره.
كان الهدف من المشروع اختبار إمكانية تطوير أفاتار لكل مواطن يكون قادرًا على جمع بياناته وتحليلها؛ الكتب التي يقرأها، الأفلام، الموسيقى، الإعجابات، التاريخ الطبي والمعلومات الضريبية، وغيرها من البيانات التي يختار المواطن منح إذن للأفاتار بمعالجتها من عدمه، وعلى أساسها يتخذ الأفاتار قرارًا بالتصويت على مشروع قانون أو ينتخب رئيسًا، وبدلا من الديمقراطية التمثيلية يطمح المشروع لاستخدام نموذج ديمقراطي أقرب للديمقراطية المباشرة عند الإغريق، لكن بمعالجة أسرع وأعمق لبيانات أكثر، بشكل يضمن تمثيل تراكبية وتعقيد القرار السياسي ويحيد بشكل كبير أثر الانحيازات النفسية دون أن يلغي تمثيلها البياني.
بالتأكيد كانت هناك شكوك تجاه تطبيقية النموذج الجديد ومخاوف من التحكم فيه من قِبل مخترعيه، لكن لضمان لا مركزية النظام، تم بناءه على تكنولوجيا البلوك تشين (تكنولوجيا يمكن بواسطتها تسجيل البيانات لا مركزيًا عبر شبكة ضخمة من أجهزة الكومبيوتر، أبرز تطبيقاتها البيتكوين)، بحيث لا يطلع على معلومات المواطن غير النظام نفسه دون تدخل جهة مركزية كوسيط، كذلك، فقد اجتاز المشروع الأبحاث والتجارب المعملية قبل إطلاقه للاستخدام الجماهيري في 2033، لتتم تجربته في المدارس والمكتبات وبعض المؤسسات غير الحكومية، ثم أنشئت برلمانات افتراضية لاختبار كفاءتها بالمقارنة مع نظائرها الواقعية.
تم برمجة نظام التشغيل وفقا لنظرية العدالة عند جون رولز بمبدئيها الرئيسيين؛ أن يُضمن أولا أن يكون الأفراد جميعا متساوين في حرياتهم وحقوقهم الأساسية دون تمييز، وثانيا ألا يخل هذا التساوي بفرص المجموعات الأقل حظًا والأكثر هشاشة، فتوضع مثلا الإثنيات المهمشة والطبقات الأفقر والأقل حظا صحيا على رأس أولويات المجتمع. إلا أن نظام هيدالجو ذهب أبعد من ذلك وفكك الأفراد نفسهم ورتب أولياته على أساس أكثر أفكارهم ومشاعرهم هشاشة واحتياجا للرعاية.
هذا النموذج من الديمقراطية لأنه يعالج أكبر قدر ممكن من البيانات، هو قادر على ضبط دقة التمثيل الديمقراطي، حيث يعترف النموذج بحقيقة أن الخطابات المكرسة للضبط الاجتماعي ستظل فاعلة ومؤثرة في أفكار ومشاعر الناس بدرجات متفاوتة وأنها سوف تعبر عن نفسها في أي نموذج إحصائي. بالتالي فرصتنا الوحيدة لتحييد تأثيرها هي تزويد نموذجنا الإحصائي ببيانات معاكسة لتخلق اتزانًا في تعبير المصالح المتناقضة عن نفسها.
تأثر نظام التشغيل بكتابات أنثروبولوجية وإثنوجرافية قدمت نقدًا قويا لطرق البحث التقليدية المتصلبة المتجاهلة الحركة المستمرة (الصيرورة) للمواضيع تحت البحث التي تهمل مرونة تلك المواضيع وعدم اكتمالها، لذلك خلق إمكانية تطوير النظام نفسه لا مركزيا بواسطة أفاتاراته.
ساهم أفاتاري جووا بيل وبيتر لوك، في بناء نظام التشغيل بإدماج مفهوم "الصيرورة" في كوده البرمجي، الشيء الذي خلق إمكانية استبدال ما سموه "التجريدات الشمولية" لنموذج نعم/لا بنموذج آخر يؤكد بشكل أكبر "تحولات الناس المستمرة وتعدد أبعادهم".
أما أفاتار عالم الاجتماع برونو لاتور ففكر في المجتمع كشبكة واسعة من الفواعل البشرية وغير البشرية يغيرون ويتغيرون ببعضهم البعض، حيث الماكرو (الكبير من الفواعل) غير منفصل عن الميكرو (الصغير منها)، النظرية التي يشار إليها باسم Actor Network Tehory، التي من وجهة نظرها يمكن أن نرى الديمقراطية التمثيلية كـ "تطهير" للسياسة من فواعل كثيرين لهم دور في الشبكة. تستولي على دورهم فواعل/ ممثلين محددين، بالتالي فالديمقراطية التمثيلية قد تبدو للوهلة الأولى مجمِّعة لأدوار فواعل اجتماعيين وسياسيين ومكثفة لهم في دور الممثل الديمقراطي، لكنها في الحقيقة تلعب دورا إلغائيًا واستيلائيًا على العدد الأوسع من الفواعل.
لاحقًا، فحص أفاتار جون لو طرق البحث التقليدية المفترض بها دراسة الواقع، كي يطرح سؤالا؛ لأي مدى تسهم الأدوات الحالية للديمقراطية في إنتاج،ـ وليس فقط تعكس، واقع التنافسية والاستقطاب السياسي والعنف والكراهية؟ ولأي مدى نموذج فيه الفواعل مدركون أن كل فعل يصدر عنهم يؤثر بشكل مباشر في المجتمع؛ قد يعزز الشعور بالمسؤولية والتشاركية؟
فلاش باك خامس
"من أجل هؤلاء الذين بلا أمل، الأمل قد يُمنح لنا" فالتر بينيامين.
السادس والعشرين من يناير 2020. في سيمينار يناقش الديمقراطية الرقمية، أسمع فرانكو بيراردي يقول "إن المشكلة السياسية [في الوقت الحاضر] تنتقل من مستوى المنطق الواعي إلى مستوى اللاوعي"، فأوقف الفيديو وأتساءل: هل الديمقراطية التقريرية واعية حقًا؟ ألا يمكن أن يكون وعيها هو المشكلة؟ أليس من المحتمل أننا نحتاج التخلي عن اختزالية الوعي وانحيازاته؟ أن نعيد تعريف الأهلية ونمنحها للفواعل بالتساوي؛ تلك الواعي منها واللا واع؟
اقرأ أيضًا: تلك الأحداث التي لا يجب ذكر اسمها
لست بطبيعيتي متفائلًا، حلولية التكنولوجيا لا تأجج حماسي، وأدرك أنها كما تخلق حلولا لمشكلات كبيرة تأتي في الوقت نفسه بمشكلات أكبر، لكني كشخص عاش تحت حكم دكتاتوري، سأتسامح بشكل أكبر تجاه أي تغيير في الأفق، رغم ذلك لا يتعلق الأمر بالتفاؤل أو التشاؤم كل على حدة، وإنما يتعلق الأمر بضرورة كليهما.
بضرورة أن أمارس الحلم كفانتازيا بديلة أتطلع فيها لعالم أود العيش فيه، أنخرط ضمنها في نشاط بشري ينتمي ربما لأحلام إنسان رسمت على جدران الكهوف قبل آلاف السنين، وضرورة أن أذكر نفسي، بينما أنا قادر على الحلم هنا والآن، بأوقات كنت فيها أشاهد الحلم من مقعد عدم الرضى، مقعد الراثي لأحلامه المهدرة، عارفًا برجاحة لا تحققها، أوقات تجلى فيها هذا الحلم كفنتازيا معكوسة لا كواقع مواز يتحقق فيه قدر أعلى من السعادة والإنجاز، وإنما كصورة، الفشل في الإمساك بها عقدة سيزيفية، كلما أوشك الحالم على الانعتاق في الصورة وبها، تذكر كونها مجرد فانتازيا، مهربًا من واقعه يتضمن بالضرورة واقعا نقيضا معاشا، يتجسد فيه الفشل مضاعفا.
لكن...
ألا يمكن لهذا الأسى نفسه أن يكون فاعلًا في تطلعنا للمستقبل والحلم به؟ ألا يمكن للشخصية الرئيسية في قصة ولاس سالفة الذكر أن تظل فاعلة في تشكيل المجال العام حتى بممارستها أقصى أشكال الانسحاب منه؟ ألا يمكن لي؟
* نُشر المقال بالإنجليزية في مجلة Arts of the working class الصادرة في ألمانيا، ضمن دورية كان موضوعها "إعادة كتابة المستقبل"، وقام الكاتب بإعادة كتابة بعض أجزاءه في نسخته العربية.



