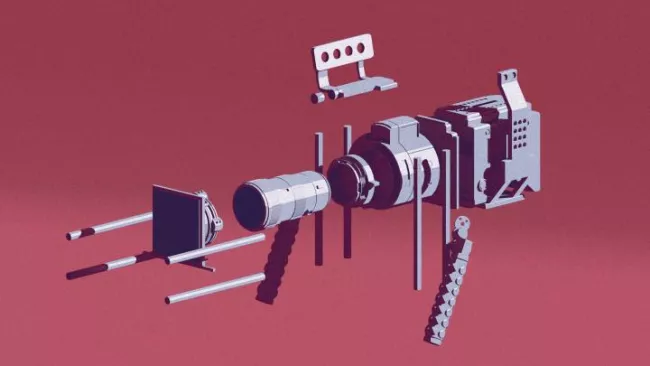ثورة افتقدت سينماها: من ناصية السينمائيين إلى سينمائيين على الناصية
هذا هو الجزء الرابع والأخير من مجموعة مقالات تحلل غياب أو وجود ثورة يناير في السينما؛ الأول عن فيلم جمعة الغضب، والثاني عن أفلامها الروائية، والثالث عن الأفلام الوثائقية.
لماذا لم تقدم السينما المصرية أفلامًا كبرى عن الثورة؟ افتتح هذا السؤال سلسلة المقالات عن السينما وثورة يناير، ومازال معلقًا، وربما نستطيع أن نقترب من بعض ملامح إجاباته العامة في هذه الحلقة الرابعة والأخيرة.
بداية هو سؤال يغري بالإجابات السهلة والمعممة، كأن نرصد تاريخ السينما المصرية في "التعاون" مع الحكام المختلفين، وننعتها كلها بأنها سينما تجارية رخيصة مثلما فعل بعض النقاد في حقب زمنية مختلفة، وبالتالي ليس من مصلحة صناعها الاقتراب من ثورة يناير إرضاء للحكام، في تجاهل لحقيقة بسيطة لا تستحق الكثير من الجدل وهي أن السينما المصرية، وكأي سينما في العالم، لها وجوه متعددة تتراوح من الرديء إلى الثمين، وأن السينما التي لعبت دورًا في تسويق الأنظمة، كانت عادة السينما التجارية محدودة المستوى.
البديل الآخر هو أن نتحدث عن عدم قدرة السينما المصرية وصُنّاعها على تقديم هذا النوع من السينما الكبيرة فنيًا، لظروف موضوعية ليس لها أي علاقة بحجم المواهب والإمكانيات البشرية المتاحة لهذه السينما، أو بعلاقات تربط بعض صناعها بالسلطة ورغبتهم في إرضائها وعمل الدعاية لتوجهاتها. وهو المدخل المناسب في تقديري لتناول بعض المسائل الأكثر تعقيدًا التي تتعلق بتاريخ السينما المصرية، والعلاقات التي ربطتها كصناعة بالدولة، وحال الثقافة في مصر عشية ثورة يناير، وميكانيزمات الإنتاج السائدة قبل وبعد يناير، دون إغفال العامل الأهم وهو المسار والمصير السياسي لهذه الثورة، وكيف وجدنا أنفسنا نواجه مع انحسارها واقعًا يمتاز بدرجة من القمع والاستبداد غير مسبوقة على مدار أغلب مراحل تاريخنا المعاصر.
وإن اشتبكنا مع بعض هذه الخطوط، وليس كلها، في محاولة الاقتراب من السؤال وإجاباته المحتملة، فعلينا التأكيد أن لا أحد يملك تقديم إجابات قاطعة أو نهائية، وأن كل السينمائيين والمهتمين بحال السينما في مصر يمكنهم الاختلاف على ملامح أي إجابة إن أرادوا، فهي في النهاية مجرد وجهات نظر، تحتمل الصواب والخطأ، ودائمًا ما ستحمل سمة عدم الاكتمال.
عسكر وسينما
في منتصف شهر أغسطس/ آب من عام 1952، بعد شهر واحد من قيام حركة الضباط الأحرار، جاء في تصريح للواء محمد نجيب أن السينما وسيلة من وسائل التربية، إن أسيء استخدامها فسيقع جيل من الشباب في الهاوية. بعد هذا التصريح بعدة أسابيع، وتحديدًا في شهر نوفمبر، يطور اللواء نجيب تصوراته عن الفن، في رسالته للفنانين، التي جاء فيها "على الفنانين أن يجعلوا رسالتهم هي رسالتنا".
ولفهم مفصلية هذه الرسائل والتوجهات من أكبر رأس للسلطة العسكرية الجديدة، علينا أن نقفز زمنيا لنصل إلى صيف عام 2017، لنجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال واحد من مؤتمراته الشبابية الكثيرة، يفسر تراجع مستوى المسلسلات بأن صناعها الحاليين مختلفون عمن سبق، هم الآن يستهدفون الربح وفقط، بينما في السابق كانت المسلسلات تحت سيطرة الدولة ولذلك كانت أفضل. وأوضح أن لديه مخططًا، وأن هذا المخطط جارٍ تنفيذه. وكرر خلال حديثه تعبير "الذوق".
تعبيرات مثل "الرسالة" و"الهاوية" و"التربية" عند العسكري الأول، تطورت إلى "الذوق" لدى العسكري الأخير، بالإضافة طبعًا إلى ضجيج الأخلاق والتربية وقيم الأسرة الذي يتكرر الحديث عنهم حاليًا ليل نهار، وكلها تعبيرات من الممكن أن تعني أشياءً كثيرة متعارضة ومتناقضة، لكننا هنا لسنا بصدد الجدل حول اللغة وتفسيرات الألفاظ، بل بصدد الوضوح الذي أبدته السلطتان، والسلطات التي تعاقبت فيما بينهما، في الاهتمام بالإنتاج المرئي والمسموع في مصر وضرورة التحكم فيه، وأن يتحول إلى بوق دعائي لكل سلطة.
في الحالة الأولي كان بشكل أساسي السينما؛ في فترة ازدهار الإنتاج والجماهيرية الواسعة للسينما المصرية، ووجود صناعة حقيقية لها في مصر، لكن في الحالة الأخرى، وبعد 65 عامًا، ولأن السينما المصرية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ليست كما كانت عليه في منتصف القرن السابق، تراجع إنتاجها وتأثيرها لصالح المسلسلات الرمضانية التي أصبحت تحتل المساحة الأولى من الاهتمام والانتشار. لم يشر الرئيس إلى السينما، اكتفى بالحديث عن المسلسلات، تاركا السينما لما يطرحه الإعلام السلطوي من حين لآخر من صلوات جماعية كي تسود ما يسمونه بالسينما النظيفة، على اعتبار أن التحكم في السينما سيأتي في ذيل عملية التحكم في المسلسلات، وهو ما حدث فعلًا.
بين اللحظتين سنجد الكثير من الدلائل على أن هناك قطاعًا واسعًا من السينمائيين المصريين ماهر في التقاط الإشارات، وعدم التمرد عليها، والتماهي مع الاستجابة لها أيضا، في مقابل قطاع آخر تواجد دائمًا في كل المراحل التاريخية للسينما المصرية وكان على درجة عالية من الشجاعة والتمرد، وبعضهم دفع أثمانًا عالية لصنع أفلام لا تنفصل عن قناعاتهم ولا تخدم أي سلطة، لكن الواقع اليومي يحسم دائما إجابة سؤال أي من القطاعين سيتمكن من العمل والإنتاج، المستجيبون أم المتمردون؟ والإجابة محسومة، يحددها من يملك الأموال أو السلطة، أو كليهما.
مستجيبون ومتمردون
بين لحظتي اللواء والمشير، سنجد مفارقات على درجة من الكوميدية أحيانًا، وعلى درجة من البؤس والمأساوية أحيانًا أخرى، فبعد نجاح حركة الضباط الأحرار بأسابيع قليلة، وبقرار اتخذته بضع لجان يشارك بها مثقفون وفنانون وعسكريون، يبدأ العمل في فيلم يمجد الضباط الذين قاموا بالحركة المباركة، ويقع الاختيار على أحمد بدرخان لإخراج الله معنا، وعلى إحسان عبد القدوس لكتابة قصته، كنوع من أنواع التكريم للاثنين، فالأول هو مخرج ومنتج الفيلم الممنوع من العرض في العهد الملكي مصطفى كامل، والثاني وريث روزاليوسف المتحمس للضباط وصاحب المقالات الملهمة لهم قبل الثورة.
يمعن فريق الفيلم في تمجيد حركة الضباط والعهد الجديد، وهو ما يجعلهم يتأخرون في إنهائه، والحركة المباركة ليست على عجل، فالمهم أن يكون الفيلم الأول الذي يمجدها على أعلى مستوى، لدرجة أن الجيش يوفر لفريق الفيلم كل الإمكانيات كي يجري العمل على أكمل وجه، ويزور اللواء نجيب موقع التصوير في استوديو مصر بصحبة بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة ليحيي فريق العمل ويعدهم بلقائهم في السينما يوم العرض الأول، لكن الرغبة في إتقان العمل تجلب المشاكل أحيانًا، فخلال شهور التأخير انقلبت الأوضاع؛ صراعات داخل مجلس قيادة الثورة تنتهي بعزل نجيب ووضعه في الإقامة الجبرية عام 1954، يتغير شكل القيادة، يمسك جمال عبد الناصر وضباطه بكل السلطات، يتم القبض على إحسان عبد القدوس نفسه، ويمنع عرض الفيلم حتى يتم تعديله، وحذف كل المشاهد التي يظهر فيها زكي طليمات، الذي لعب دور محمد نجيب كقائد للثورة.
بعد عقود، وقبل اللحظة التاريخية لثورة 25 يناير، ومآلاتها التي قادت بعد شهور طويلة رئيس المخابرات العسكرية لمنصب رئيس الجمهورية، كان الفيلم التجاري صرخة نملة للمخرج سامح عبد العزيز جاهز للعرض، بنهاية تتلخص في أن المظلومين سوف يلجؤون للرئيس مبارك الذي سيتدخل لحل مشكلتهم. لكن الثورة تندلع قبل عرض الفيلم مباشرة، يسقط مبارك بعد 18 يومًا، فيتم تغيير كل نهايته لتتلاءم مع الواقع الجديد، فينتهي بثورة المظلومين على مبارك نفسه، وليس اللجوء إليه كحاكم عادل سينصفهم.
لا أستطيع تجاهل نكتة أن صناع الفيلم ربما رغبوا في صياغة نهاية ثالثة بعد 3 يوليو/ تموز 2013، تتمثل في لجوء المظلومين لجهاز المخابرات.
إن ابتعدنا عن الدعابات سنجد أن التجربتين دالتان على حالة الاستجابة السريعة لقطاع من السينمائيين للتغيرات الكبرى في شكل النظام، وتكتملان ببعض الظواهر السينمائية التي وُجدت بينهما، منها ظاهرة بعض الأفلام الاجتماعية في حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن السابق، التي وإن تناولت مسائل اجتماعية تضعها في سياق العهد الملكي البائد، أو تتجنب تحديد زمن الأحداث، فتبدو وكأنها من الممكن أن تنتمي إلى أي عصر وإلى أي مكان، أو تقدم إعلانات في بداياتها تنفي عن الزمن الحالي أي شيء مسيء، أو تشير إلى أن كله من وحي الخيال، أو ما تطور فيما بعد وسمي بسلسلة أفلام "الكرنكة"، نسبة لفيلم الكرنك الذي لم يفتتحها ولكنه كان ذروتها، وكانت وظيفتها الساداتية تصفية الحساب مع نظام عبد الناصر وما سمي بمراكز القوى.
الثابت تاريخيًا بين لحظتي اللواء نجيب والمشير السيسي، الذي تحولت الثورة في عصره عبر كثير من الأفلام والمسلسلات إلى ثورة البلطجية واللصوص أو المؤامرة الدولية الإخوانية، ليس فقط استجابة قطاعات من السينمائيين للسلطة وإرادتها، فهذه الاستجابة لم تكن طواعية بالكامل، بل نتيجة لتوازن قوى واقعي بين السينمائيين من ناحية والسلطات من ناحية أخري، لتنتصر دائما رؤية السلطة للسينما والتلفزيون باعتبارهما مجرد أدوات دعائية، استطاعت التحكم فيهما تمامًا عبر عدد من القوانين واللوائح البيروقراطية والقمعية، وعبر جهاز الرقابة، وتدخل الأجهزة السيادية فيما تقرر أنه موضوع سيادي أيًا كان، وعبر آليات التمويل والدعم التي تضمن تحكم موظف السلطة في عمل المبدع السينمائي، وأيضًا عبر ميكانيزمات الإنتاج الخاصة التي تم تكريسها عبر التاريخ الطويل للسينما المصرية، بحيث نجد أفلامًا قليلة هي ما تستطيع النجاة من خرم إبرة كي تنتقد في الزمن الصحيح، أو تستطيع تقديم قراءات جادة للواقع الآني ولمشاكله، وغالبا لأن صانعيها قد تمكنوا من استغلال مجموعة تناقضات سياسية واجتماعية فرضت على السلطة في لحظات معينة أن ترخي قبضتها، مثلما هو حال فيلم المتمردون للمخرج الراحل توفيق صالح، وإن دفع ثمن المرور من خرم الإبرة لاحقًا.
الفيلم من إنتاج سنة 1966، لكنه ظل ممنوعًا لمدة عام ونصف، حتى سُمح بعرضه في صيف 1968؛ السماح بإنتاجه كان في لحظة تناقضات في الرؤى بين قوى مختلفة داخل النظام، وازدواجية التنظيم السلطوي بين "الاتحاد الاشتراكي العربي" العلني، و"التنظيم الطليعي" السري، والسماح بعرضه جاء بعد هزيمة ذلك النظام في الحرب وانهيار المشروع الناصري، وحاجة السلطة لترك مساحة من حرية التعبير قبل أن يحدث انفجار يطيح بها، وعبر هذه المساحة استطاع توفيق صالح بالتعاون مع الكاتب صلاح حافظ، أن يقدم قراءة رمزية ناقدة لعهد عبد الناصر، ولشخصية "القائد بالصدفة" المتجسدة في شخصية الطبيب المريض "عزيز" الذي يقود التمرد داخل مصحة العزل لمرضى الدرن، لكنه ورفاقه حين يتولون السلطة في المصحة يواجهون بحقيقة أن ليس لديهم أي تصور عن شكل إدارتها أو السياسة التي سيتبعونها، فتغلب على خطواتهم سمة العشوائية، دون أن ينسوا ضرورة تأسيس نظام ديكتاتوري جديد، فتنهار سلطتهم ويعود النظام القديم.
دون الوقوع في سطحية أفعل التفضيل؛ الأفضل، الأبرز، الأشجع إلخ، فالفيلم دون شك من أجرأ الأفلام التي قدمتها السينما المصرية في نقد السلطة قبل زوال هذه السلطة وليس بعدها، فكان العقاب ثلاثيًا، فبعد منع الفيلم لأكثر من عام ونصف، تم إجبار فريقه على إضافة نهاية تفاؤلية ليس لها أي علاقة بمسار أحداثه، لتغازل النظام الذي سيتعلم من أخطائه السابقة، وفي تقديري أن العقاب الثالث كان وضع عدة دوائر حمراء حول اسم توفيق صالح، تمنعه، ضمن أسباب أخري، من الاستمرار في عمله كمخرج سينمائي، ليضطر بعدها إلى الخروج فيما يشبه المنفى المؤقت إلى سوريا والعراق، ليصف توفيق صالح حالته بعبارة "مطرود من مصر بشكل مؤدب"، في خطاب وجهه لسمير فريد في مطلع عام 1970، ويستمر عقابه حين يعود لاحقًا إلى مصر، رغم تغير السلطات بتوجهاتها.
ضباط السيناريوهات
بالعودة إلى مفارقة اللحظتين العسكريتين كلتاهما، اللواء والمشير لم يعبرا عن مجرد طموحات، بل عبرا بوضوح عن سياسات ومخططات كان يجري العمل عليها بالفعل؛ في الحالة الأولى عبر تشكيل وزارة الإرشاد القومي الجديدة، وتعديلات قانون الرقابة، وإلغاء الأحزاب، ومنع صحف، وتأميم السينما والإعلام فيما بعد، وفي الحالة الثانية تكرار إجراءات شبيهة بالحالة الأولى مع مزيد من القمع بعد ثورة يناير، بكل مفردات القمع التي نعلمها جميعًا.
لكن الفرق بين لحظتي تأسيس سلطة العسكر الأولى وتأسيس سلطة العسكر الثانية يتجلى أساسًا في وجود أو غياب مشروع تنموي حقيقي. امتلكت سلطة يوليو هذا المشروع، فاكتسبت تدريجيا الوعي بأن هذه التنمية ومشروع تأسيس مجتمع الطبقة الوسطي يحتاجان أيضا للثقافة والفنون وتنميتهما، وأن شرط وجودهما هو إتاحة بعض النوافذ المفتوحة أحيانًا كي يتمكن صناعهما من التنفس والعمل، دون إلغاء كامل للقيود والسيطرة.
لكن ثورة يناير 2011 فعلت ما تفعله الزلازل، قامت بتفكيك طبقات وشرائح النظام المستقر إلى شلل وقطاعات وأجهزة تعبر عن مصالح متعارضة، لكنها مشاركة بشكل أو بأخر في السلطة، أو تملك مقومات التأثير فيها، فلا خيار أمام سلطة السيسي سوى السيطرة الكاملة، لا تستطيع أن تغامر بترك نوافذ مفتوحة قد يتسلل منها من لا تريده، لا تملك ترك الحبل على الغارب لتظهر أفلام ومسلسلات وبرامج وقنوات تلفزيونية تتناول بجدية وعمق ثورة يناير وتدفع تصوراتها وطموحاتها إلى الأمام وتقوم بتطويرها، أو تقدم وجوهًا جديدة قد تتحول لقيادات حقيقية لهذه الثورة، هي لحظة استعادة التحكم العسكري في إدارة الدولة بالكامل، كسبيل وحيد لتجنب انهيار النظام، والحفاظ على مصالح الشلل برغم التناقضات بينها، وهو ما يفسر ربما الشراسة المبكرة في التعامل مع الثورة منذ اللحظة الأولى.
قبل ذلك الحديث الذي ألقاه الرئيس في مؤتمر الشباب بسنة كاملة، كانت الخطوات قد اتخذت فعلا للتحكم الكامل بالملف الإعلامي سياسيًا، وليس فقط عبر أساليب الترهيب والرعب، بداية من تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وما صاحبه من خطوات سياسية أخرى، نستطيع أن نسميها اختصارا بـ"السياسة السينيرجية"، وكيف تحولت شركة إنتاج متوسطة الحجم لإخطبوط يبتلع أغلب الإنتاج التلفزيوني بقنواته عبر مجموعة "إعلام مصريين"، والمجموعة المالكة لها "إيجيل كابيتال"، وإن كان القارئ يود الإطلاع أكثر على علاقات هذه المجموعة بأجهزة سيادية عليه مراجعة عدد من التحقيقات التي نشرها موقع مدى مصر خلال عامي 2017 و2018، وبالذات مقال حسام بهجت عن تفاصيل استحواذ المخابرات العامة على إعلام المصريين.
اقرأ أيضًا: فك وتركيب الإعلام: جيل جديد وإعداد مركزي لـ "التوك شو" وفصل جماعي
في تلك الفترة نفسها حكى لي أحد المشاركين في كتابة مسلسل رمضاني لم تنتجه سينيرجي، كيف كان على فريق الكتابة أن يرسل الحلقة المنتهية إلى ضابط محدد في جهاز الأمن الوطني، مكلف بمتابعة المسلسل، وبعد قراءة الضابط للحلقة، فإنه يستدعي الشخص الذي حكى لي القصة، فيذهب إلى مكتبه ليقابله، ثم ينبهه الضابط عادة إلى عدد من مشاهد الحلقة مطلوب تعديلها، دون أن يقترح لها حلولًا درامية بديلة طبعًا، فيعود الفريق ليحاول نسج الحلقة من جديد، ربما يجدون حلولًا درامية وفنية تنال رضا الضابط في الاجتماع التالي.
هذه النوعية من الحواديت أصبحت عادية التداول في الأوساط السينمائية والمسلسلاتية المصرية، حتى وإن كانت شركات الإنتاج ليست بصدد إنتاج فيلم أو مسلسل، لكن بعض ملاكها يتلقون من حين لآخر مكالمات من الضباط المسؤولين عن هذا الملف الفني "المعقد"، للتواصل، ولما هو أهم.. أن تتكرر إشارة "نحن هنا".
ناصية السينمائيين
لفهم المشهد الحالي علينا العودة إلى مفتتحه، إلى لحظة الثورة، في سردية مختصرة ربما نفهم عبرها هذا المسار.
بعد احتلال ميدان التحرير يوم 28 يناير، والاستقرار فيه بعد موقعة الجمل يوم 2 فبراير/ شباط، هلت بشائر الأعداد الأكبر من السينمائيين المصريين على الميدان، كثيرون كانوا قد شاركوا في تظاهرات الأيام السابقة، والبعض ممن لم يشارك أتى أو تضامن تحت وطأة الانبهار بالفعل التاريخي الكبير الذي كان يحدث، وللمرة الأولى يصبح لهؤلاء السينمائيون تجمع "شوارعي" بعيدًا عن المكاتب أو النقابة أو مواقع التصوير، فيتمركز السينمائيون أساسًا في ملتقى شارع التحرير مع الميدان من ناحية كوبري قصر النيل، فيما كان يطلق عليه وقتها بـ "ناصية السينمائيين".
مع بداية أيام الملل والانتظار قبل تنحي مبارك يوم 11 فبراير، وكرد على دعم اتحاد النقابات الفنية رسميًا لنظام مبارك، وبداية تفاوض الإخوان مع عمر سليمان، اجتمع في أحد الحجرات الضيقة من دار ميريت للنشر أربعة من السينمائيين من نفس الجيل، نكتفي بذكر واحدة منهم وهي السيناريست والكاتبة الراحلة نادين شمس، ليقوموا بصياغة بيان بعنوان "سينمائيون معتصمون في ميدان التحرير"، بلهجة غاية في الجذرية والوضوح، معلنين عن أن اتحاد النقابات الفنية لا يمثلهم، وكذلك رفضهم لأي تفاوض مع النظام الفاقد للشرعية، والتأكيد أن الشرعية الوحيدة هي للثورة المصرية.
تصور من صاغوا هذا البيان أن التوقيعات عليه لن تتجاوز العشرات القليلة، لكن المفاجأة كانت انتشاره الواسع وتوقيع مئات السينمائيين عليه، فعقد خلال الأيام التالية اجتماعان للسينمائيين بمقر أتيليه القاهرة في شارع كريم الدولة، ليتقرر خلالهما القيام بتظاهرة تنطلق من مقر النقابة بشارع عدلي، باتجاه ميدان التحرير، إن أسعفتني الذاكرة فقد حدثت يوم التاسع من فبراير.
سقط مبارك، تفرق الميدان، لكن بعض السينمائيون ذهبوا للاعتصام في مقر نقابتهم كاستمرارية لهذا الحراك الثوري، ومن أجل نقابة ديمقراطية، للمرة الثانية في تاريخهم بعد الاعتصام الشهير في صيف 1987، لكن ما جمع المصريين كهدف موحد كان قد تحقق، إسقاط مبارك، وهنا تأتي الهزيمة الأولى، أو أول بوادر الضعف والتفرق، فيفشل الاعتصام النقابي بسبب بروز الخلافات بين صفوفه، مابين الداعين لانتخابات مبكرة، أو عزل النقيب والتحقيق معه، والداعون لنقابة جديدة ومستقلة، فينفض الاعتصام دون أي إنجاز حقيقي.
ما حدث في النقابة يتكرر بشكل شبيه في اللجنة التي شكلها وزير الثقافة للإشراف على إدارة المركز القومي للسينما، مع الإبقاء على رئيسه المرفوض من كثيرون، والذي يدير أيضا الرقابة على المصنفات الفنية، ولأن هذه اللجان لم ينتخبها أو يختارها السينمائيين، بالرغم من أن بعض أعضائها يحظون باحترام واسع، أصابها الضعف بسبب عزلتها عن أرضيتها الطبيعية وهي جموع السينمائيون، فضاع الوقت في الخلاف حول الاكتفاء بالمهمة المحددة بالإشراف على إدارة المركز، أو محاولة ضم جهاز الرقابة إليه كمناورة لإبعاده عن أيدي الإسلاميين قبل انقضاضهم على السلطة، أو أصوات أضعف كانت تنادي بتنظيم مؤتمر واسع لعموم السينمائيين المصريين لوضع سياسة متكاملة وجديدة تخص مهنتهم، ومن ضمنها إلغاء جهاز الرقابة، وكنت ممن ارتبطوا بذلك التصور الأخير، وأستطيع أن أشكك الآن، بعد عشرة سنوات، في إن كنا قادرين وقتها فعلا على إلغاء الرقابة.
أثناء الخلاف والنقاش تنحسر الثورة وتتراجع تدريجيًا، ينحسر أيضًا الحشد السينمائي لأسباب كثيرة وموضوعية، مثلما انحسر الحشد الشعبي خارج نطاق السينمائيون، ليتم استدعائه في بعض المناسبات والأحداث، المفتعلة أو التلقائية، التي صاحبت كل منها مذبحة جديدة، لم تتحول أيا منها للمادة الدرامية الأساسية لفيلم تسجيلي أو روائي، وهو ما يحمل دلالات كثيرة.
حشد السينمائيين اجتمع جزئيًا في لحظتين محددتين تاليتين، الأولى لحظة الاعتصام في مكتب وزير الثقافة تمهيدا لأحداث 30 يونيو/حزيران 2013، الذي عزف عن المشاركة فيه بعض قطاعات السينمائيين لأسباب سياسية مبدئية، واللحظة الثانية بعدها بشهور، وتحديدًا مع نهايات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، حين يجتمع القليلون ليصيغوا بيانًا يستعيد اللهجة الثورية القديمة الواردة في بيانهم الأول خلال احتلال الميدان، هذه المرة لرفض قانون التظاهر الجديد وبند المحاكمات العسكرية للمدنيين الذي كان يوضع أثنائها في الدستور الجديد، ولأن اللحظة مختلفة، غابت عنها الجموع، وتأتي بعد مذبحة واسعة كمذبحة رابعة، تراجع عدد المشاركين في ذلك الاجتماع، وانفض دون الاتفاق على البيان أو إصداره.
ليست هذه هي السردية الوحيدة والمتكاملة لمسار اشتباك السينمائيين المصريين مع الثورة، هي جزء من ذلك المسار، لا ينفي عشرات المبادرات والمحاولات الأخرى، لكن.. هل تتجاهل هذه السردية ما يتعلق بالمنتج السينمائي الفني وتتطرق فقط للمسار السياسي/ الفئوي للسينمائيين؟ نعم، فقد تناولنا في الحلقات السابقة بعض هذه المنتجات الفنية، هذا التناول حتى وإن كان غير مكتمل فهو لا ينفي مركزية حديثنا الآن عن المسار السياسي، لأنه كان العامل الحاسم في ألا تتح الفرصة أمام السينمائيين المصريين لتقديم أفلام كبرى عن الثورة، ففي حالة الإنتاج السينمائي إن أردت أن تنقله خطوات للأمام، وأن تستفيد من لحظة تغيير مجتمعي كبرى كي تمنحه وجوها وميكانيزمات جديدة، فإنك لا تملك الابتعاد عن السياسة، ولا تملك الاكتفاء بزخم المبادرات الفنية الفردية والتلقائية، أو ما يملكه الفنانون في مجالات أخرى، حيث تنجو فنونهم من كابوس "المأسسة".
انتعشت فنون أخرى بفضل الثورة، ووجد بعض مبدعيها طرقًا جديدة للتعبير تصنع قطيعة ولو مؤقتة وجزئية مع التعبيرات القديمة، لكنها تحديدًا الفنون التي لا تحتاج إلى مؤسسات وشركات تنتجها أو تسوق لها في عملية شديدة التعقيد والتكلفة مثلما هو الحال بالنسبة للسينما.
يمكننا بسهولة ملاحظة انتعاش فنون الكتابة، سواء في أشعار أو نصوص أدبية أو مقالات، وانتعاش الموسيقي ومسرح الشارع محدودي التكاليف، وكذلك الفن التشكيلي، وبالذات الجرافيتي، وربما ما قام به الفنان محمد عبلة هو مشهد شديد الدلالة على ذلك الانتعاش، عندما حمل لوحة رسمها للفتاة التي عرفت بـ"ست البنات" التي سحلت وتمت تعريتها في أحداث مجلس الوزراء، وسار بها في الشارع ليضعها في الميدان، مقدمًا إياها لجمهوره الطبيعي الذي رسمها وهو واع بتوجهه إليهم.
لكن صناع السينما انقسموا في لحظة الثورة أمام مشهد "المأسسة" الذي ظل لعقود طويلة يتحكم في منتجاتهم، لا يعلمون كيف يواجهونه وكيف يغيرونه، ولم يجد المتمردون على هذه المأسسة الفرصة لعمل أفلامهم الكبرى في زحام المعارك، ربما للانشغال بها كمواطنين، وربما رغبة في تأمل اللحظة التاريخية بتمهل أكبر فربما تنتج فنًا أكثر نضجًا فيما بعد، لكنهم في كل الأحوال وجدوا أنفسهم محاطين بقوى أخرى تحدد شكل ومضمون إنتاجهم، فيفقد عفويته، على عكس منتجات فنية أخرى نجت من الرقابة والنقابة والمركز القومي، وشركات الإنتاج والتوزيع ومالكي مفاتيح المهرجانات الدولية، وكأن قدر السينما المصرية بنوعيها التسجيلي والروائي أن تظل محكومة بقوالب علاقتها العضوية بالسلطة وهياكلها، ربما حتى تأتي لحظة تغيير مقبلة تخلصها من هذه القيود وتخلصها أيضا من "النخبوية".
الغوغاء ركبوا يا باشا
نعم.. هي "النخبوية" مرة أخرى، تناولناها في الحلقات السابقة بجانبيها المتعلق بتصور الفنان النخبوي عن ثورة شعبية، والمتعلق باختيار شخصيات من النخبة لتلعب بطولة الأفلام، لكن جانبها الثالث هو نخبوية الإنتاج، وتمركزه في عدد قليل جدًا من الشركات والجهات المنتجة، التي تحصل في أحيان كثيرة على تمويل مشاريعها من عدد أخر قليل من جهات الدعم والتمويل الأوروبية أو الإقليمية، وهو مشهد إنتاجي شديد البؤس مقارنة بحقب أخرى وجدت فيها عشرات من شركات الإنتاج والتوزيع ومئات من قاعات العرض، حين كان تمويل الفيلم المصري يتم عبر شباك التذاكر، والبيع اللاحق في البلدان العربية، لكن عهد مبارك وتحديدًا في منتصفه، وبقوانين السينما الشهيرة، لم يقم فقط بتدمير ما تبقي من الصناعة، بل أنه قدمها هدية لتحتكرها شركات قليلة جدًا، تتحكم في المنتج وشكله ومحتواه، حتى ما سمي لاحقا "بالسينما المستقلة"، الذي أفضل تسميته بـ"السينما منخفضة التكاليف"، فقد تمأسس الإنتاج في أغلبه تدريجيا لصالح شركتين أو ثلاثة.
لكن نخبوية السينمائيين لها ملامح أبعد زمنيًا؛ ميكانيزمات صناعة السينما بشكلها القديم تمنح العاملين فيها هالات لا مرئية حول رؤوسهم للشعور بالتميز والتفوق، لسببين أساسيين وتاريخيين، أولهما الغموض الذي يحيط بعملية صناعة الفيلم شديدة التعقيد، وكانت تبدو سابقًا وكأنها طقوس سحرية مرتبطة بماكينات كبيرة ومعقدة وحيل لا يستطيع العامة فهم كيفية تنفيذها، والسبب الأخر هو نظام النجوم، الممثلون المشهورون الذين بمجرد أن ينتسبوا لفريق عمل فيلم أو مسلسل ما يمنحون الآخرين ممن يعملون به هالة من الأهمية لمجرد أنهم يخالطونهم.
تستطيع أن تضيف إلى ما سبق في تفسير النخبوية، إن أردت، عامل عزلة المثقف المصري، التي لم تنكسر إلا في استثناءات قليلة، وتجعله يتصور في عزلته، حتى ولو كانت إجبارية كعقاب من الدولة، أنه أكثر وعيًا ممن يعبر عنهم أو يتوجه إليهم بمنتجه الفني والثقافي، إن لم تتفق معي فعليك نسيان هذه الفقرة ولنواصل.
في النصف الثاني من التسعينات، وبالتوازي مع قوانين الاحتكار المباركية، جاء تطور كاميرات الفيديو الديجيتال ودخولها لمجال صناعة الأفلام، وما سيتتبعه من موجة الأفلام منخفضة التكاليف، لتحطم الكثير من دوائر هذه الهالة النخبوية بمجرد كسرها لغموض الصناعة بماكيناتها الكبري، وتقديمها للعديد من الأفلام دون نجوم، وبميزانيات محدودة، ورغم هذه "الدمقرطة" لوسيط السينما، استمرت النخبوية باتخاذها لأثواب جديدة: حجم الإنتاج الكبير إن استطعت توفيره، شبكات العلاقات، القدرات الخاصة في الحصول على فاندات (دعم) دولية وإقليمية، واللجان المختلفة المشكلة في مؤسسات الدولة الثقافية، ومدى قدرة السينمائي على العبور إليها.
"الغوغاء الثائرون" الذين ركبوا يوم جمعة الغضب 2011، وأشار إليهم الشرطي بتعليقه الدقيق "الشعب ركب يا باشا"، غابوا عن السينما التي تناولت الثورة، بالرغم من أنهم كانوا الجمهور الذي يقف بالطوابير فيما سبق أمام السينمات كي يدعم بقروشه القليلة الأفلام المصرية، وهم الغوغاء أنفسهم الذين التفوا ليحموا الجداريات ورسومات الجرافيتي وقت المواجهات وبعدها، ويحمون فنانيها، ويساعدوهم كي يعيدوا رسمها من جديد في كل مرة قامت السلطات بإزالتها، هم من التفوا حول شعراء ومغنين يقفون على منصات أنشئت على عجل في الشوارع، من أمثال رامي عصام، أو فريق كاريوكي، أو إسكندريلا، دون حواجز تفصلهم عن جمهورهم، وبأغانيهم المعبرة عن ذلك الجمهور، لكنهم لم يلتفوا حول السينما لأنهم لم يجدوا أفلامًا تعبر عنهم كي ينشروها ويحموا صناعها ويتوجوهم كنجوم لثورتهم، بل كانوا يحملون هواتفهم بكاميراتها في مواجهات الصفوف الأولى، ليسجلوا عشرات الآلاف من الفيديوهات وكأنهم صناع أفلام، وشخصيات فيلمية في الوقت نفسه، لكنها مشاهد غير مكتملة ولن تتحول أبدا إلى أفلام.
علي سبيل الختام الحزين
في نهاية المقال السابق أشرت لبعض "إنجازات" مبارك في تجريف الواقع الثقافي والفني والتعليمي في مصر خلال ثلاثين سنة، وأشرت إلى سحب المثقفون إلى الحظيرة وهي العملية التي كانت مستمرة قبل مبارك، وافتتحت مع اللواء الأول، لكن واحدًا من إنجازات مبارك هو خلق حالة من حالات النفور من السياسة، والنظر إلى الاشتباك السياسي باعتباره أدلجة للفن، وطريق للهبوط بهذا الفن، وتحويل نظرة أجيال من الفنانين والسينمائيين للسياسة والمعارضة إلى نظرة نفور ولا مبالاة، وهو ما يفرق بعض الأجيال السينمائية الحالية عن أجيال أخرى سابقة كانت تشتبك بأفلامها مع السياسة، دون أن تخاف من وصمها بالأدلجة.
وقفت قطاعات من السينمائيين في لحظة الثورة تتأمل عملية الصراع التاريخي، وتشارك بها، وتتعارك مع واقع "مأسسة" السينما، اختفي نفورها من السياسة مؤقتًا، وفي انتظار لحظة الهدوء كي تختمر أفلام كبري عن ثورتها، لكن لحظة الهدوء حين حلت لم تكن سوى بداية للقمع السلطوي المباشر والمنظم، كانت تعبيرًا عن هزيمة نهائية للثورة، وابتعاد أي حلم للحرية الحقيقية التي هي الشرط الأساسي لوجود سينما طازجة وحرة في تناول ثورتها.
وكأن وقت صناعة الأفلام انقضي سريعًا خلال عامين ونصف، تم استنزافه في محاولة الحصول على الحرية الحقيقية، ومحاولات مبعثرة لتمكين هذه الثورة بشعاراتها الفضفاضة، انقضى فيما أسميناه بالمذابح المجهلة، وفي خوف السينمائيين الطبيعي من الإخوان، ونفورهم منهم، لأسباب تاريخية قديمة، ولأسباب حديثة تمثلت في إشارات الإسلاميين غير المبشرة على الإطلاق أثناء حكم مرسي أو قبله، وهو ما دفع قطاع من السينمائيين للوقوع الطبيعي في فخ خطابات العسكرة أو النظام القديم.
اشتباك السينمائيين مع الثورة والسياسة جاء كجملة اعتراضية في المنتصف، وبعد تراجع الصراع السياسي، وهزيمة الثورة الأخيرة، عاد ذلك النفور من السياسة ليصبح من جديد الشعور السائد، ولنتناول نموذجين لفيلمين حديثين من أفضل الأفلام التي تم إنتاجها مؤخرًا، يعبران عن محاولتين لصنع سينما مختلفة بعيدة عن النجوم، وبشخصيات حقيقية، وفي الأماكن الحقيقية أيضًا، وهما فيلما تامر السعيد أخر أيام المدينة (2016)، وفيلم أبو بكر شوقي يوم الدين (2018)، أيًا كانت الملاحظات على خطوطهما الدرامية، وإن كانت "مطبوخة" معًا بشكل جيد أم لا.
لقي فيلم أبو بكر شوقي الاحتفاء من قطاعات سينمائية مختلفة، بالطبع بسبب جودته، لكن أيضًا بسبب جوائزه الدولية، ووجود شركة "فيلم كلينيك" بشعارها في مقدمته، والتعاطف الإنساني مع بطله المصاب بالجذام، لكن فيلم تامر السعيد، لم يلق الاحتفاء نفسه برغم جوائزه الدولية، ولم يجد التضامن الكافي حين تم منعه من مهرجان القاهرة بحجج غير منطقية، اعترفت لاحقًا إدارة المهرجان بأنها كانت حججًا كاذبة، لتضع ويا للمفارقة الكوميدية بدلا منه في المسابقة الرسمية فيلم المقاول المنشق الشهير البر التاني شديد الرداءة.
ولم يجد فيلم أخر أيام المدينة التضامن الكافي مرة أخرى خلال رحلة الآخذ والرد مع الرقابة من أجل التصريح بعرضه، السبب في تقديري هو أن فيلم تامر السعيد يشتبك مع السياسة، وإن دارت أحداثه قبل الثورة، ويتناول أربعة محاذير بالنسبة للسلطة الحالية، نشير إليها سريعًا، بالرغم من أن الفيلم يستحق كتابة أوسع: هتاف "يسقط حكم العسكر" الذي يتكرر في الفيلم، علاقة الحب خارج إطار الزواج بين البطل وواحدة من الشخصيات النسائية، وتمرد البطل خالد (خالد عبد الله) على الكابوس الديني المتزمت المحيط به، والعامل الرابع لا يقل أهمية، ففي الوقت الذي تتردد فيه إعلاميا الجملة فاقدة المعني "مش أحسن ما نكون زي سوريا وليبيا"، يأتي تامر السعيد ليشير بفيلمه إلى أن المدينة تنتهي ومن الممكن أن تلقى المصير المأساوي لبيروت أو بغداد.
نعم.. السياسة هي اللعنة، إن كنت معارضًا بالطبع، في ظل غياب قوى معارضة حقيقية حمت أفلام جادة في بلدان أخرى مرت بظروف مشابهة، وفي غياب قنوات إنتاجية وتوزيعية بديلة ومتنوعة وأقرب لنموذج التعاونيات، مثلما هو حال سينمات أخرى، مع حضور كابوسي للقمع والتنكيل ليكملا الصورة، تمت ملاحقة البعض، وقطع عيش الآخرين، أو إجبارهم على الرحيل، وربما تكون الحالة الأبرز هي حالتي عمرو واكد وخالد أبو النجا، شبه المنفيين خارج مصر، والمنتج السينمائي المعتقل منذ شهر مايو/أيار الماضي معتز عبد الوهاب.
أما من نجوا بالصدفة من الملاحقة، أو من المنفى، أو من السجن، دون أن يعلموا سبب نجاتهم بسبب عشوائية سياسة القمع نفسها، فبعد صخبهم على ناصية السينمائيين لم يجد بعضهم سوى الرضا بالعمل المتاح، أو الرضا بناصية البطالة، إجبارًا أو اختيارًا، يتأملون واقع السينما والسينمائيين، ومن حين لآخر، يستعيدون هذا الوهج الذي ملأ حياتهم خلال عامين ونصف، وانتهي، ربما يرددون بحسرة أنه كان حلما وانتهي نهاية كارثية، وربما يحتفظون بمذاق أيام التوهج والثورة.