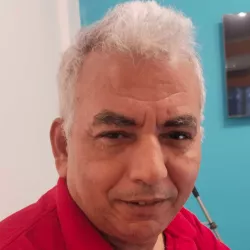كفر السنابسة.. الرحلة التي لم نعد منها
الأحد الماضي، دعت الزميلة إيمان عوف، رئيسة لجنتي المرأة والحريات بمجلس نقابة الصحفيين، لتشكيل وفد من الصحفيين لزيارة أسر ضحايا كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في المنوفية، وتعزيتهم والتعبير عن التضامن معهم. حينها لم أتوقع أن تلقى الدعوة استجابة واسعة في الوسط الصحفي، لكن حدث العكس، واستجاب أكثر من 25 زميلًا وزميلة، غالبيتهم من النساء.
ربما تعود الاستجابة السريعة والواسعة بين الصحفيات إلى أن الدعوة صدرت من رئيسة لجنتي المرأة والحريات في النقابة، إلى جانب الشعور بأُخوّة النساء، فمن بين 19 ضحية، 18 فتاة كُنَّ يكافحن من أجل لقمة العيش.
قطعنا الكيلومترات المائة التي تفصل كفر السنابسة عن القاهرة في ساعتين. على الخريطة يمكن تصنيف القرية ضمن قرى الريف القريب من العاصمة، لكن الواقع يقول عكس ذلك.
فور وصول أتوبيس الوفد إلى القرية أيقنت أن السفر لم يكن في المكان فقط، بل في الزمان أيضًا، فالقرية التي تفصلها عن القاهرة عشرات الكيلومترات فقط، بعيدة عن مظاهر التطور والحداثة على مستوى العمران والبنية الأساسية بعشرات السنين.
قرية من زمن قديم
لفت انتباهي أول ما لفت البيوت القديمة المبنية بالطوب اللبن، وهي طريقة قديمة جدًا في البناء واختفت تقريبًا من غالبية قرى الريف المصري، سواء في الدلتا أو الصعيد، وحلت محلها المنازل المبنية بالخرسانة والطوب الأحمر. كانت تلك أول مظاهر الفقر في القرية، فنسبة لا بأس بها من السكان ما زالوا يعيشون في بيوت الطوب اللبن هذه.
عرفت من أحد أهالي القرية أن غالبية الأيدي العاملة فيها لم تتمكن من السفر إلى دول الخليج أو ليبيا قبل الحرب، وبالتالي لم تتغير البيوت القديمة كما حدث في قرى مجاورة، وحتى العمالة التي تتمكن من العثور على فرص عمل في القاهرة فإنها في الغالب لا تجني الكثير.
لم نجد صعوبة في العثور على مجالس العزاء، فدون أن نسأل عن أماكنها قادتنا أصوات تلاوة القرآن إلى الحُصر المفروشة أمام الكثير من المنازل ليستقبلنا آباء الضحايا، فيما يقود البعض الصحفيات لداخل المنازل، لتقديم واجب العزاء للأمهات والنساء من أهالي الضحايا.
مجالس عزاء بسيطة، مجرد حُصر مفروشة أمام المنازل، وبعض الوسائد المتناثرة عليها، وعدد من المقاعد يدعى الضيوف للجلوس عليها، ولكن أبرز ما في تلك المجالس هو إحساس الفاجعة الذي يظهر مع كل نظرة وكلمة.
من بين المفجوعين تحدثت مع يحيى خليل، والد الضحيتين جنى وشيماء، 15 و19 سنة، بدأ حديثه معي بتفاصيل تلقيه خبر الحادث "الساعة تسعة ونص أو عشرة الصبح جالي تليفون، حد بيقول، هات عربية وتعالى خد البنات من على الإقليمي، ولما سألت مين، جالي الرد مش مهم مين تعالى خد البنات".
يضيف "رحت على هناك وصلت لقيت العربية اللي كانوا راكبينها خردة، ولما سألت قالوا لي كلهم ماتوا، قالوا السواق كان نايم أو واخد مخدرات، طب هما يعني عرفوا ازاي في ساعتها كده إنه واخد مخدرات، أي كلام بيقولوه وخلاص".
تبدو قدرة الأب على الحديث أصعب عندما يصل للحظة التي يتحدث فيها عن مصير ابنتيه "عرفت بموت جنى وشيماء، وبنت عمهم ملك. أروح على فين؟ البنات اتوزعوا على المستشفيات، جنى في مستشفى الباجور وشيماء في قويسنا، طب أجري على مين فيهم الأول؟!".
أطياف الضحايا
يسترسل الأب في الحديث عن ابنتيه كما لو أنه يحاول إعادتهما للحياة بالتمسك بالحديث عن تفاصيل حياتهما وخطط المستقبل التي لن تتحول إلى واقع أبدًا "شيماء كان جايلها عريس، واحد ابن حلال من البلد هنا، أهي راحت للي أحسن من العريس. لما خدت الإعدادية قالت لي أنا عايزة أشتغل وأساعدك عشان تبني البيت".
ويكمل "نِزْلت الشغل وهي 14 سنة، كانت بتشتغل وتدخل جمعيات عشان تساعدني". يجيل الأب النظر في أرجاء البيت الذي ساعدت شيماء في بنائه "عملت جمعية وقالت لي خد عشان الأبواب والشبابيك، وجمعية تانية عشان المحارة، وكل شوية تعمل جمعية عشان تساعد في تشطيب البيت، وأهي ماتت وما لحقتش تعيش فيه".
ينتقل الأب إلى الحديث عن جنى " كانت شاطرة وبتاعة علام، جابت 250 من 280 في الإعدادية، كان نفسها تدخل تمريض عسكري، كانت شاطرة ونبيهة، وكانت بتنظم وقتها بين الشغل والدراسة وشغل البيت".
بفخر واضح على وجهه الحزين يخرج هاتفه ويفتح صورة قائلًا "دي قصيدة بنتي جنى كانت كاتباها ولقيناها في فرشتها، كانت بتحب العلام وكانت شاطرة"، وعندما يصل الحديث عن التعويضات يتحدث الأب باستخفاف "تعويضات إيه، ما فيش حاجة تعوضنا، بناتنا ماتوا. إيه اللي ممكن يعوضنا بقى؟ ولا الدنيا كلها تعوضنا".
نريد المحاسبة
في اللحظة التي تطرق فيها والد جنى وشيماء للحديث عن عدم اكتراثه بالتعويضات تدخل شقيقه محمد وقال لي "التعويض ما يغنيش عن المحاسبة، واللي غلط يتحمل غلطه، مقاول الأنفار اللي ما حدش عارف راح فين، إزاي عربية بتشيل 14 نفر يحط فيها زيادة عن عشرين وبيعدي أوقات 25 نفر عشان يوفر، يعني حمولة عربيتين يحطهم في عربية".
المطالبة بالحساب لم تقتصر على مقاول الأنفار الذي استخدم سيارات مخصصة لنقل البضائع والمواشي لنقل العمال من وإلى المزارع خارج القرية ولكنها شملت مكتب العمل. يضيف محمد عم الضحيتين جنى وشيماء "فين مكاتب العمل اللي بنسمع عنها، لو فيه مكاتب عمل شايفة شغلها ما كانتش البنات دي ماتت على الطريق كده".
يتطرق محمد إلى جانب آخر من المأساة "المقاول بييجي البلد بالعربية، يحملها ويمشي، من سبعة الصبح لسبعة وتمانية بالليل يطلع عينيهم في الشغل 12 ساعة بيومية 130 جنيه، اليومية دي بياخدوها من المقاول، ومنعرفش بيحاسب المزرعة على كام، ولا حتى ينفع نسأل اليومية كام". هكذا تبدو علاقات العمل في القرية مثل أبنيتها ومظهرها، تنتمي إلى عصور سحيقة حيث لا قوانين للعمل تحمي العامل وتضمن له العمل في بيئة آمنة.
ينضم للمطالبة بالحساب سعيد عبد الغني، جد الضحية هنا مصطفى، 16 سنة "الطريق الإقليمي كمان السبب، بيقولوا السواق كان شارب مخدرات، طب في نفس اليوم حصل حادثتين، برضو السواقين واخدين مخدرات، وتاني يوم اتقلبت عربية أمن مركزي، سواق الأمن المركزي برضه واخد مخدرات؟ زي ما المقاول مسؤول، فاللي عمل الطريق ده برضه مسؤول".
تقى الجوهري 16 سنة، واحدة من ضحايا الحادث، يرى عمها أن المسؤولية لا تستثني المزرعة التي كان المقاول يورد إليها العمال ويقول "المزرعة اللي كانوا رايحين يشتغلوا فيها، مزرعة السعد ناحية مطار سفنكس، ما سألتش، ولا حتى حضر منها حد يعزي في اللي ماتوا، ولما جت سيرتهم، صاحب المزرعة قال إن المزرعة أجازة في اليوم ده، مع إن فيه ناس راحت من البلد برضه في نفس اليوم للشغل، كانوا تلات عربيات وصل عربيتين والثالثة اللي عملت الحادثة".
ويضيف "المزرعة شايلة إيدها من أي حاجة، بتتعامل مع المقاول وبس، وإحنا ولا نعرف حتى اليومية، المقاول هو اللي بيقبض، والنقل عليه، ولو حد حصل له أي حاجة المزرعة ما لهاش دعوة، وطبعًا المقاول لا هناخد منه حق ولا باطل".
حزن وغضب
الحزن الذي يلف القرية لا يخفي الغضب في قلوب أبنائها، ومع هذا الغضب حديث الفخر والاعتزاز الذي يظهر في صوت الآباء مثل يحيى خليل "بناتنا كانوا بيكافحوا عشان يعيشوا وعشان يساعدونا، كانوا تعليم وأدب وأخلاق وتدين ما تلاقيش زيهم في الدنيا، بنات شقا صحيح لكن كانوا رافعين راسنا وساندينا، كانوا يستاهلوا عيشة أحسن من كده، والحمد لله على كل شيء، قضا ربنا قابيلنه، لكن بناتنا ما كانوش يستاهلوا يموتوا على الطريق كده".
يعدد الجد سعيد ما تعاني منه القرية من مشكلات "قلة الشغل في القرية بتخلينا نروح على الجبل والمزارع برة البلد، محتاجين توفير شغل، محتاجين مشاريع منتجات ألبان وخضار وفاكهة، مشاريع الناس تشتغل فيها هنا بدل الشحططة في كل حتة باليومية".
ويضيف "القرية كمان ما فيهاش غير مدرستين ابتدائي، الفصل فيه زيادة على 70 عيل، ومدرسة إعدادي واحدة، إحنا اللي عملناها بالجهود الذاتية، ومش مكفية، وما فيش معهد أزهري، محتاجين مدارس، والوحدة الصحية، خرابة وما فيهاش حاجة ولا حتى دكتور، ومركز الشباب خرابة برضه، وما فيش صرف صحي في البلد، وكسح الطرنشات بيكلفنا كتير، البلد تعبانة قوي، وبناتها زي شبابها كده بيجروا في كل حتة عشان لقمة العيش".
حديث الحزن والغضب والمطالبة بالمحاسبة والمطالبة بتحسين أوضاع القرية لا ينتهي، ولكن اليوم ينتهي. القطار أفضل وسيلة للعودة، لأنه يضمن لنا مواصلة الحديث مع أهل السنابسة وقرى أخرى تشبهها. القطار المنطلق من المحطة التي تحمل اسم القرية يشبهها، زجاج الشبابيك محطم والمقاعد متهالكة والفواصل بين العربات تبدو خطرة، يبدو كالقرية تمامًا قادم من عصر سحيق.
جولة بين العربات تكفي للشعور بأن القطار ما زال في القرية، فتيات في نفس أعمار الضحايا، ومجموعات من الشباب يتحدثون عن العمل في الموسكي بالقاهرة في إجازة الصيف.
بعد أكثر من ساعتين وصل القطار لمحطة رمسيس في العاصمة، لتنتهي الرحلة، ولكن مع ترجلي من القطار وسيري على رصيف المحطة، وجدت نفسي تلقائيًا أراقب شابًا، يبدو قادمًا من الريف للعمل، رغم زيه المديني، وفتيات يسرن متلاصقات كما لو كن يحتمين ببعضهن في الغربة، وسيدة في منتصف العمر، تحمل كيسًا بلاستيكيًا جمعت فيه ملابسها ومتعلقاتها.
أجدني رغمًا عني أتفحص وجوه القادمين من الكفور أو النجوع أو القرى من خارج العاصمة، الذين نجوا من حوادث طفيفة أو محتملة وسيناريوهات دموية، وجاءوا إلى القاهرة للبحث عن لقمة العيش، حتى بعد مغادرة المحطة يستمر المرء في البحث عنهم ليكتشف فجأة أن الرحلة إلى كفر السنابسة لم تنته بعد وأنه لم يفارق أهلها.