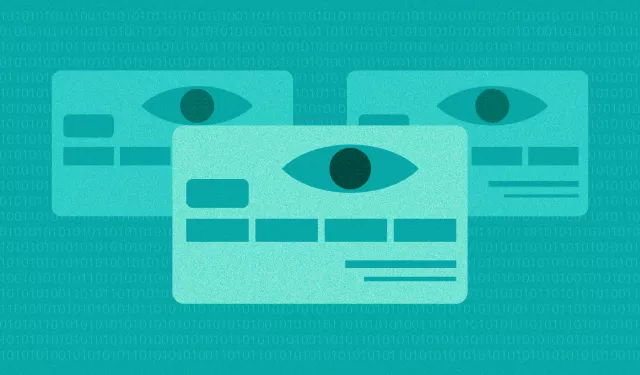
محفظة مليئة بالكروت: الخاسرون من رقمنة القطاع المصرفي
"عملية السحب مرفوضة. رجاء الاتصال بخدمة عملاء البنك".
ظهرت أمامه تلك الرسالة على شاشة ماكينة الصراف الآلي، تقف حائلًا بينه وبين شراء احتياجات المنزل في هذا اليوم، رغم تأكده التام من وجود رصيد كافٍ بحسابه. لم يكن بالبنك سوى موظف الأمن حيث كانت الساعة تخطت السابعة مساءً، وليس سوى الماكينات الصماء بالمنطقة الخارجية الصغيرة للبنك. ليس من يشكو له، ولا أحد يشرح ما العطب بحسابه.
موقف بسيط وعادي وأغلب الظن أن المشكلة ستُحل في صباح اليوم التالي ببساطة، ولن يموت أطفال العميل جوعًا حتى ذلك الحين، وربما يكون هناك عيب مؤقت بهذه الماكينة تحديدًا، وتعود للعمل لاحقًا، وقد تقبل ماكينة أخرى عملية السحب دون مشكلات. فالموضوع ليس بقضية كبرى ويُمكن تقبله بالنظر إلى المميزات الأخرى الكثيرة الذي يقدمها الشمول المالي، أو عملية أتمتة ورقمنة القطاع المصرفي. أبسط ما يُمكن قوله إنه لولا الصراف الآلي لما كانت هناك أصلًا إمكانية للوصول إلى النقود في السابعة مساءً خارج مواعيد العمل الرسمية بالبنوك، وإنه يوفر الكثير من الوقت الذي يضيع في انتظار الدور والإجراءات الروتينية وملء قسائم السحب عند التعامل مع الموظفين مباشرة، ويتيح للعاملين التركيز في أعمال أخرى لرفع كفاءة البنك. وينسحب ذلك أيضًا على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل سوق الأوراق المالية، وعمليات الشراء، والتسوق عبر الإنترنت، ودفع الفواتير، وغيرها. بعبارة أخرى: لقد أصبحنا نحمل في محافظنا كمًا لا متناهٍ من البطاقات اﻹلكترونية، تفوق في بعض الأحيان عدد أوراق النقد التي كنا نحملها في الماضي، وصارت حياتنا كلها تسير على مناطقها الممغنطة، حتى إننا نتحول شيئًا فشيئًا في إلى وضع حياتنا رهن تطبيقات الدفع الإلكتروني على الهواتف المحمولة.
مثل هذا التحول مع إيجابياته التي لا تخفى على أحد، له نواحٍ سلبية، وهو ما سنحاول التعرض له تفصيلًا في ثنايا هذا المقال، لأن رقمنة وأتمتة القطاع الاقتصادي بمثل هذا الشكل الراديكالي والسرعة المذهلة التي نشهدها حاليًا، لها انعكاسات خطيرة على هيكل سوق العمل وبالتالي أوضاع العمالة، خاصة في دول العالمين الثاني والثالث وفي قلبها بلد مثل مصر.
واﻷتمتة تعني التشغيل اﻵلي، حيث يكون التدخل البشري في حدوده الدنيا، أما الرقمنة فهي تحويل جميع المعلومات والوثائق إلى صورة تستطيع أجهزة الكمبيوتر التعامل معها.
لا أود هنا طرح الخطاب التقليدي الذي يفضله الكثيرون من جيلي، غير الراغبين أساسًا في التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة لاعتبارات تراثية وثقافية وحياتية مختلفة، وهم في المجمل يختصرون الموضوع في أن الرقمنة تضر بفرص العمل وستؤدي حتمًا إلى القضاء على جزء كبير منها. وهذا صحيح بالطبع بشكل مبدئي ولكن في المحصلة النهائية غالبًا ما ستتساوى الأمور لأن الرقمنة مثلمًا ستجعل الاستغناء عن كم كبير من الوظائف ممكنًا، ستُحتم أيضًا خلق عددًا ليس بالقليل من الوظائف الأخرى، ربما تفوق حتى تلك التي تمت خسارتها.
مزيد من البطالة
المُشكلة الحقيقية ليست في عدد الوظائف بل في نوعيتها، فالوظائف الجديدة التي ستظهر في مجال التكنولوجيا تحديدًا ستحتاج إلى نوعيات من المهارات والقدرات والخلفيات التعليمية ليست بالضرورة متوفرة لدى عامة الناس، واكتسابها في الكثير من الأحيان يتكلف أموالًا غير متوفرة لديهم، وما سيحدث بالتالي هو حراك طبقي رأسي للوظائف من أسفل إلى أعلى، أي من الطبقة العاملة إلى البرجوازيات بدرجاتها المختلفة، حيث سيحل مثلًا خريج المعاهد التكنولوجية بنوعياتها مكان الفني البسيط الحاصل على "دبلوم الصنايع"، والذي لم تمكنه ظروفه المادية من الاستمرار بالدراسة لما بعد الثانوية وهكذا.
ويختلف الحال بالطبع من دولة لأخرى، حيث قد يكون في مقدور البلدان التي لديها ما يكفى من الإمكانيات أن تنفذ برامج شاملة لتأهيل العمالة، حتى تتكيف مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل في إطار نظام تعليمي متقدم، ولكن الدول التي لا تملك تلك المقومات، فستخسر شعوبها كثيرًا بكل تأكيد.
ويكفينا في هذا الصدد معرفة أن حتى دولًا صناعية واقتصادية كبرى مثل ألمانيا، كان التحول إلى الأسواق في عالم الإنترنت بسبب أزمة انتشار جائحة كورونا أحد أهم أسباب زيادة أعداد العاطلين بما يقدر بــ 520 ألف فرد[1] في أول ارتفاع من نوعه منذ العام 2013، رغم ازدهار قطاعات هامة في الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع تجارة التجزئة في الإجمالي بنسبة 1.5%، ولكن معظمها جاء من التجارة الأونلاين، التي ربحت حوالي 15% بينما خسرت المتاجر التقليدية نحو 11% من إيراداتها على مدار العام السابق.[2]
نعلم بالطبع أن جائحة كورونا خلقت حالة اقتصادية استثنائية في العالم كله، ولكن يظل الأمر عنصر مؤشر، لما قد يحدث في حالات التحول الرقمي عمومًا، بعيدًا عن دوافعه.
لا يؤدي ذلك بالضرورة إلى أرقام أعلى للبطالة، ولكنه بكل تأكيد سيضغط هؤلاء إلى وظائف أدنى، حتى مما كانوا عليه من قبل وبأجور أكثر تدنيًا، وليس بمستبعد أبدًا أن تكون نتيجة ذلك حالة جديدة من الفقر الشديد لفئات واسعة من الشعوب، ناتجة عن مثل هذه التحولات الاقتصادية والصناعية الجذرية.
ربما لا يكون أدل على ذلك من حالة جنوب أفريقيا، وهى إحدى الدول التي سلكت درب الأتمتة والرقمنة على مدار العقد الأخير وأحرزت فيه تقدمًا كبيرًا، وشهدت رغم ذلك تراجعًا دراماتيكيًا في نموها الاقصادي من 3.04% عام 2010 إلى 0.153% في نهاية عام 2019.[3] وزيادة ملحوظة في نسب البطالة من حوالى 25% عام 2012 إلى 28% على وجه التقريب عام 2019 [4] وهو ما يوازى 708 ألف فرد تقريبًا.[5] وتزامن ذلك مع ارتفاعات ملحوظة في ثروات كبار أثرياء البلاد، مثل يوهان روبرت الذي يعمل في استيراد وتوزيع المنتجات شديدة الرفاهية، ووصلت ثروته مؤخرًا إلى 7.3 مليار دولار[6] أو كووس بيكر الذي اشتهر لتحويله إحدى كبريات دور نشر الصحف في جنوب أفريقيا إلى عملاق في التجارة الإلكترونية، ومُقدم للخدمات التليفزيونية الحديثة Cable TV بثروة إجمالية تبلغ قيمتها اليوم حوالى 2.8 مليار دولار.[7]
لا نقول هنا بالضرورة أن الأتمتة والرقمنة هما السببان الوحيدان لهذه التطورات المؤسفة، ولكنهما بكل تأكيد من الأسباب الرئيسية لأن مثل تلك الأرقام لا تأتي تزامنًا مع تغيير جذري في الهيكل الاقتصادي اعتباطًا ولا من قبيل المصادفة.
بعبارة أخرى؛ تُتيح الأتمتة والرقمنة بهذا المفهوم الفرصة للمزيد من استعباد قوى العمل المأجور، أي العمال الذين يحصلون على راتب ثابت يحدده صاحب العمل حسب رؤيته، مقابل ما يقدمونه من عمل، وغالبًا ما يكون أقل بكثير من القيمة المٌضافة التي ينتجونها بالفعل، ولن يكون أمام هولاء حينئذٍ سوى القبول والرضوخ للأمر الواقع، نظرًا إلى قلة أو حتى انعدام البدائل المتاحة أمامهم حتى يجدون قوت يومهم.
هذا يعني أننا سنصير أمام هيكل جديد تمامًا في علاقات الإنتاج، ربما يكون تكوينه أكثر ظلمًا حتى للأغلبيات الكاسحة مما نراه اليوم. وإذا كان هذا صحيحًا حتى بالنسبة لبعض الدول الاقتصادية المتقدمة، في ظل الهيمنة السياسية للاتجاهات المحافظة (ألمانيا مثلًا تحت حكم المستشارة أنجيلا ميركل أو فرنسا في حقبة نيكولا ساركوزي سابقًا والآن إيمانويل ماكرون)، فما بالنا بدول عديدة أقل تقدمًا حول العالم مثل مصر، حيث تعاني شعوبها الأمرين أصلًا من فقر وجهل وانهيار التعليم، وضعف البنية التحتية التكنولوجية.
البقاء للأغنى
الأخطر حتى من التأثير على سوق العمل بالشكل الذي أسلفنا ذكره هنا هو ما سيكون لعملية الأتمتة والرقمنة من مردودات على أنماط وطرق استهلاك الأفراد والجماعات، وتوزيع الأنصبة السوقية ما بين الشركات بمختلف أحجامها وإمكانياتها وهيكلة سلاسل الإمداد، وقدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على البقاء حيًا.
الحقيقة أن التقدم التكنولوجي الذي نشهده الآن، مع الاعتراف مجددًا بكل ما يحمل من مزايا، لا يخلو بالمرة من كونه أيضًا أداة طيعة في أيدي الشركات العملاقة العابرة للجنسيات والرأسماليات الكبرى، للانفراد بالأسواق وشبه احتكارها في مجالات عديدة. فاليوم أصبح الشراء من المواقع الإلكترونية مثل أمازون هو الاتجاه السائد، ويفوق في مجالات عمليات محددة الشراء من منافذ الببيع التقليدية.
وليس أدل على ربحية هذا النموذج حول المعمورة، وفي العالم العربي كذلك، من استحواذ أمازون على موقع سوق الإماراتي عام 2017 مقابل 650 مليون دولار أمريكي، خاصة لما كان سوق بدوره يستحوذ على 78% من إجمالي التجارة الإلكترونية في المنطقة[8] التي بلغت في 2016، 22.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل هذا العام 48.8 مليار دولار[9] وربما سيزيد هذا الرقم كثيرًا إذا استمرت جائحة كوفيد-19 على مدار العام.
منطقيًا، يؤدى بنا ذلك إلى أن شركة مثل أمازون (المعروفة باستغلالها الشديد للعمالة[10]) ستكون في المستقبل المتحكمة في جزء كبير من نوعية ومنشأ المنتجات التي يستهلكونها مواطنو الشرق الأوسط، وحتى الكميات التي يستهلكونها بها، خاصة أن حجم السوق المُتاح لا يزال كبيرًا جدًا، حيث تبلغ نسبة التسوق عبر الإنترنت في المنطقة حوالي 2% من حجم تجارة التجزئة الكلية بها [11]، أى أن فرص التوسعات في المرحلة الحالية لانهائية.
ولا يحتاج الأمر إلى خبير متعمق في الاقتصاد كي نتصور أن ذلك سيشكل أيضًا وبقوة هيكل الأنصبة السوقية للشركات، فمن له منافذ بيع إلكترونية خاصة به وقادر على إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني، خاصة بطاقات الائتمان وبدرجة ما أيضًا بطاقات الخصم المباشر، ومن سترضى عنه شركات على شاكلة أمازون والعملاق الصينى علي بابا، أو سلاسل المتاجر التقليدية الكبرى مثل مترو، وسبينيس، وكارفور، التي تتيح الدفع الإلكتروني بدورها، هو من ستنتشر منتجاته ما بين المستهلكين ويجد الفرص التسويقية المناسبة، أما البقية الباقية وتحديدًا المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فلها الله وغالبًا ما ستفلس معظمها أو تضطر إلى بيع أصولها. هذا لأن صغار التجار والصُناع يكون في الكثير من الأحوال من الصعب عليهم الانخراط في منظومات الدفع الإلكترونية الآجلة بطبيعتها، بينما يحتاج هو إلى السيولة الناتجة عن مبيعاته يوميًا وليس شهريًا أو حتى نصف شهريًا.
أما المشكلة اﻷخرى هنا، فترتبط مفصليًا بفئة العملاء التقليديين لمنافذ بيع التجزئة وهي بنسبة كبيرة تنتمي إلى أفراد ليست لهم حسابات بنكية، ومن ثم لا يملكون البطاقات المقدسة التي تُمكنهم من الشراء بهذه الطريقة أصلًا.
لنتذكر هنا أن مصر ليست القاهرة والجيزة أو الإسكندرية، حيث يُمكن أن تتاح وسائل الدفع الإلكتروني بالأكشاك ويملك العامل البسيط بطاقة ائتمان، ولكن لو ذهبنا إلى قرى البحيرة أو كفرالشيخ أو سوهاج أو غيرها من المحافظات المُهمَّشة، خاصة في صعيد مصر، سنجد وضعًا مختلفًا تمامًا، حتى بالنظر إلى انتشار ماكينات الــPOS بها، فبطاقات الدفع نفسها غير منتشرة بالقدر الكافي، والمنظومة الضريبية المصرية بشكلها الحالي ستقضى على الجزء الأكبر من أرباح التجار. ولسنا ننادى طبعًا بإتاحة التهرب الضريبي ولكن نطالب بمعاملة تفضيلية مؤقتة لهولاء، حتى يكون ذلك حافزًا لهم للإقبال على النظام الجديد.
صحيح أن الحكومة تتحدث كثيرًا عن مسألة الشمول المالي (أي إتاحة الخدمات المصرفية بجميع أنواعها للمواطنين كافة) وتطلق مبادرات مثل بطاقة ميزة، ولكننا لا زلنا نعيش في بلد تبلغ فيه نسبة تيسير الوصول البنكي Accessibility Rate (عدد ونسبة المواطنين القادرين على الوصول إلى الخدمات المصرفية) حوالى 30%[12]، معظمها متمركز في المدن الكبرى، أي أن حتى التوزيع الجغرافي معيوب، وتعويض مثل هذه النسبة في تلك الحالة أمر يحتاج إلى مجهود كبير على أصعدة مختلفة، يتعدى كثيرًا مجرد استحداث بطاقة دفع أو افتتاح فرع بنك أو تحديث مكاتب البريد.
هذه كلها في حد ذاتها بالتأكيد مجهودات محمودة، ولكنها بنفس التأكيد غير كافية أيضًا. بعبارة أخرى: الشمول المالي ليس مسألة إتاحة وسائل دفع الكترونية، ولكنه نظام أشمل يحتوي بنية قانونية ومجتمعية تُمكن كافة المواطنين من إجراء كافة معاملاتهم المالية عن طريق المصارف بمختلف أنواعها، والحصول على القروض وما شابه، وخطة واضحة لدمج الاقتصاد غير الرسمي دون الإضرار بالقائمين عليه، ومنظومة ضريبية عادلة وشفافة إلخ، أما مجرد ملء محافظ المواطنين بالمزيد والمزيد من البطاقات، فلن يُجدي نفعًا.
غياب البنية التحتية
كما تقوم أتمتة ورقمنة الاقتصاد على فكرة وجود بنية تحتية قوية لوسائل الاتصالات الحديثة من إنترنت وإرسال تليفزيوني وتغطية هاتفية (أو ما يسمونه Triple Play في عالم خبراء الاتصالات). والمشكلة الواقعية هنا في مصر ليست رغبة الدولة في فعل ذلك ولكن في عدم وجود الإمكانيات المادية له حيث أن الشركات المتحكمة في فضاء الاتصالات المصرى كلها شركات أولًا وأخيرًا هادفة للربح وتعتبر بالطبع جدوى توصيل أو تحديث الشبكات المذكورة بأعلى إلى وفي العديد من المناطق ضعيفة للغاية، إما بسبب قلة الكثافة السكانية (الوادي الجديد مثلًا) أو على خلفية ضعف القوة الشرائية بها (معظم مناطق الصعيد)، أي أن المنتجات التي يمكنهم تقديمها على شبكاتهم سيكون الإقبال عليها محدودًا في كلتا الحالتين.
هذا على الرغم من أن الدولة المصرية قدمت نماذج ليست سيئة أبدًا فيما يتعلق بقدرتها على بناء بيئات ذكية كاملة متكاملة، في مجموعة المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية (هذا على الأقل من حيث المبدأ وعلينا انتظار النتيجة النهائية) ولكنها من ناحية أخرى مُدن مُخصصة للنُخب الاقتصادية وبالتالى من الصعب تصور أن يمتد تأثيرها لباقى ربوع البلاد وخاصة المناطق الريفية والنائية.
والحل هنا بسيط في الحقيقة وهو يتمثل في وجود إرادة لدى الدولة بتحمل تكاليف مد الشبكات كاملة، حتى تصل إلى نسبة نفاذ لا تقل بأي حال من الأحوال عن 80%، إذا رغبت فعلًا في التقدم والازدهار.
بطاقات أكثر.. شموليةأقوى
أما الجزئية الأخيرة التي نود التطرق إليها، فهى تلك الخاصة بالجانب السياسي والاجتماعي، والذي سيُخرجنا قليلًا عن السياق الاقتصادي ولكنه في الوقتذاته هام للغاية، لكونه يؤثر على الاقتصاد في نهاية الأمر، لأننا في الحقيقة نخلق ثقافة استهلاكية وانتاجية وخدمية مختلفة تمامًا عن كل ما تعودنا عليه في الماضي وتبعدنا تمامًا عن نسقنا الاجتماعي المعتاد من ناحية، ومن أخرى نتيح للدولة إمكانيات غير مسبوقة لمراقبة المواطنين مراقبة شبه كاملة، دون أن يتطلب ذلك مجهودًا أمنيًا من أي نوع، وبما يمكّنها من إساءة استخدام المعلومات التي ستتاح لها من خلال ذلك، لخلق بيئة سياسية أكثر شمولية.
والخطر الكبير الذي نراه هنا على وجه التحديد هو وصول قوى يمينية، حتى ولو معتدلة نوعًا أو أنظمة عسكرية وشبه عسكرية إلى سدة الحكم، وهو احتمال قائم دائمًا حتى في دول ذات تراث ديمقراطي راسخ، مثلما حدث عند انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، أو تقلُّد بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني، وكذلك في دول كانت على الأقل تتجه نحو شكل ديمقراطي، كما نرى في حالة البرازيل برئيسها الحالي جايير بولسونارو، فما بالنا بدول لم تر ديمقراطية حقيقية في تاريخها برمته، أو لفترات قصيرة جدًا فقط مثل تركيا ومصر والنظم الملكية في الخليج وأغلب دول الاتحاد السوفيتي السابق، إلخ.
في مثل هذه الحالات يمكن جدًا أن تتحول الرقمنة وعملية الشمول المالي تحديدًا إلى سيف مُسلط على رقبة المواطنين والمؤسسات بأنواعها، مُهددًا حريتهم في التعامل بدرجة كبيرة ويمنح الدولة كل ما تحتاجه لتتدخل في أدق تفاصيل حياتهم الشخصية، ولاستخدام المعلومات التي تحصل عليها عن هذا الطريق ضدهم أو للتنكيل بهم بمزاعم مختلفة وقتما تشاء والأمثلة على ذلك كثيرة وكانت لها نتائج مأساوية في بعض الأحيان وتتخطى بالطبع مجرد المجال الاقتصادي.
اقرأ أيضًا: لماذا ينمو الاقتصاد المصري وتزداد مع ذلك معدلات الفقر؟
صحيح أن الشمول المالي مفيد للغاية في مكافحة جرائم مثل التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وصحيح أيضًا أنها تساعد الدولة في التخطيط الاقتصادي والتحكم في المعروض النقدي لكبح جماح التضخم، ولكن أن يُتاح للسلطات التنفيذية في دولة ما الإطلاع على تفاصيل مشتريات الأفراد وأفضلياتهم ومتابعة أنماط استهلاكهم ومعرفة طبيعة علاقاتهم الشخصية، إذا ما تُرجمت إلى معاملات مالية، كالمساعدات العائلية والمدخرات التعاونية، فهذه كلها معلومات يجب أن تتمتع بحماية خاصة، ولا يكفي في هذا الصدد وجود قانون يمنع البنوك من إطلاع السلطات على حسابات العملاء، طيلة ما ينص ذات القانون على إلزامها بفعل ذلك بناءً على أحكام قضائية، لأننا إذا ما افترضنا أصلًا أن حكومة إحدى الدول تريد إساءة استخدام تلك المسألة، غالبًا ما تكون استقلالية ونزاهة القضاء في هذه الدولة موضع شك هي الأخرى.
الخلاصة من كل ما سبق إذن، هي أن لا أحد منا يدعو إلى الاستغناء عن التكنولوجيا الحديثة في أى مجال مهما كان، وأنا شخصيًا ضد شيطنتها لأن هذا هو تحديدًا ما حدث مع كل تقدم في تاريخ البشرية، وأدرك تمامًا أن كافة ما يستجد في حياتنا من اختراعات مثلما يُمكن استخدامه بما فيه منفعة للناس يُمكن أن يُساء استخدامه، فلم يكن أينشتاين يقصد صناعة قنبلة هي الأكثر تدميرًا منذ أن وجدوا البشر على كوكب الأرض عندما شطر الذرة، وكانت نية ألفريد نوبل وقت اختراعه الديناميت أن يُساعد بذلك في عمل المناجم والإنشاءات، وليس أن يُستخدم في تفجيرات إرهابية.
ولكن عملية الرقمنة تحديدًا لا يوجد ما يمنع أن نضع لها حدودًا من الآن، وفي هذه اللحظة بموجب قوانين ومواد دستورية ترسم لها حدودًا واضحة لا يجوز تخطيها ولا يُمكن تأويلها، مثل المورفين الذي يُستخدم بشكل رسمي وعلني لأغراض طبية مختلفة، ولكن لا يُزال مُجرّمًا تعاطيه على سبيل "الكيف".
ليس الأمر في الاقتصاد بنفس هذه البساطة بالطبع، ولكنه ليس بمستحيل أيضًا إن خلُصت النوايا. دعونا لا نتسبب في إفقار الملايين من الأسر حول العالم، دعونا نمنع تعميق الهوة ما بين الفقراء فقرًا شديدًا والأثرياء ثراءً شديدًا، وتركيز الثروات في أيدي القليلين. وقبل كل شيء دعونا لا نجبر المواطن على البوح بأسراره الشخصية، كلما دخل يشترى القليل من الجبن أو اللحم من السوبر ماركت.
[1] موقع Statista.
[2] موقع جريدة Das Handelsblatt الألمانية بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2020.
[3] موقع البنك الدولي.
[4] موقع Statista.
[5] موقع البنك الدولي.
[6] موقع City Press بتاريخ 5 يناير/ كانون اﻷول 2020.
[7] موقع مجلة فوربس الأمريكية.
[8] موقع إيجيبت إندبندنت بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2017.
[9] موقع المكتب الاستشاري العالمي المعروف Deloitte.
[10] موقع مجلة تايم الأمريكية المشهيرة بتاريخ 18 يوليو 2019.
[11] موقع Go-Gulf.
[12] موقع The Banker بتاريخ 1 أبريل/ نيسان 2020.


