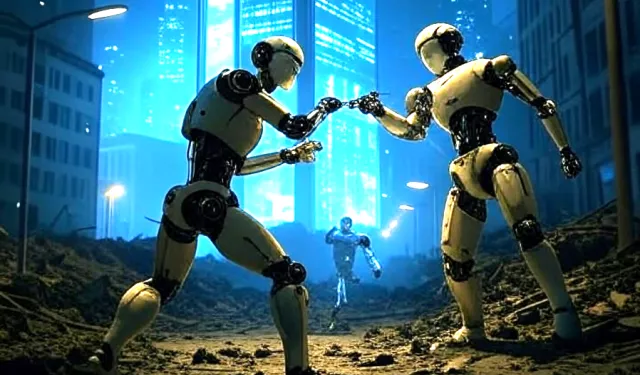
هامش الخطأ المقصود.. عن خطورة عسكرة الذكاء الاصطناعي
"كل ما مخَض عنه الخيال البشري من إبداعات الشرّ الخارقة، وما بلغته التكنولوجيا من قِدم، يجري امتحان فاعليّتها في أجسادنا اليوم"، يلخِّص الشاعر الفلسطيني محمود درويش بمقولتِه ضمن نصِّه ذاكرة النسيان طبيعة المرحلة التي نحياها، وتتفاعل فيها المادة والتقنية بشكل مباشر وحاسم مع الفكر والجسد، وتخرج الوسائط عن حدود دورها التقليدي حاملًا محايدًا للمعرفة إلى ساحة توجيه وصنع القرار، بل وحسم مصائر البشر.
ليس الإعلام مجرد كلمة مقروءة أو صوت مسموع، بل يشمل كل عنصر مادي يحمل إمكانية التواصل، من الجسد إلى السلاح، ومن السيارة إلى السكة الحديد، ومن الصورة الفوتوغرافية إلى الدائرة الرقمية.
الذكاء الاصطناعي إضافة أصيلة في ترجيح توازنات القوى بين البشر والتكنولوجيا
هذه الفكرة المحورية بلورها الباحث الألماني فريدريش كتلر (1943 - 2011)، مؤسس ما يُعرف بالدراسات المادية والتاريخية لوسائط الإعلام/Media Materialism أو علم الإعلام/Medienwissenschaft. وهو أول من ناقش فكرة أن الوسائط ليست محايدةً على الإطلاق، بل تحمل ضمن تركيبها التقني والثقافي بُعدًا ماديًا وفلسفيًا يشكّل طبيعة الرسالة ودلالتها.
ليست الرسالة وحدها هي المهمة، بل كذلك المادة التي تحملها، والسياق التقني الذي يُتفاعل معها من خلاله، وكان هذا في كتابه Gramophone, Film, Typewriter الصادر في عام 1999.
الحجر المنقوش بالأحرف المسمارية، الورق المحفور بالحبر، الفيلم الملون، الصور الرقمية، الموبايل، السوشيال ميديا، ليست مجرد أوعية للنقل، بل مكونات مادية تتفاعل مع مضمونها، وتشكل، بل وتغيّر، طبيعة تأثيرها على المتلقي، كما تحدد مساحة التواصل، وآليات التفاعل، ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع.
الدراسات الإعلامية
ترتكز دراسة الإعلام وفق هذا التصور على ماديته؛ على طبيعة الوسيط الناقل، والسياق التقني الذي تُنقل عبره الرسالة ويُشكل معناها. يرى كتلر وأيضًا ثيودور أدرنو (1903-1969) وماكس هوركهايمر (1895-1973) في كتابهما Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments ضرورة أن يتمحور كل تثقيف سياسي ومجتمعي حول تجنب اعتبار الإعلام وسيطًا محايدًا.
حذّر أدورنو على نحو خاص من خطورة التقليل من ماديّة الإعلام، مؤكدًا ضرورة قراءة الإعلام باعتبارها حاملًا ماديًّا للتاريخ، قابلًا للإنتاج وإعادة التشكيل، مع أهمية تطوير وعي أخلاقي يحمي من توظيفه على نحو مسيء.
ماديّة الوسيط التقني
نعيش اليوم عصرًا تتخذ فيه ماديّة الإعلام مظهرًا آخر يتمثّل في الذكاء الاصطناعي بوصفه وسيطًا تقنيًا يحمل إمكانية صناعة القرار وتنفيذ مخرجاته على الأرض.
في هذا السياق لا بد من العودة إلى المنظّر الكندي في مجال الإعلام مارشال ماكلوهان (1911 - 1980) الذي وصف القرن العشرين بأنه القرن الذي يسعى فيه البشر لامتلاك أكبر قدر من السلطة عبر أصغر تقنية ممكنة، واليوم نجد الذكاء الاصطناعي مثالًا حيًا على هذا التنبؤ، الذي أورده في كتابه الأشهر Understanding Media، الصادر عام 1964.
قياسًا على تصورات ماكلوهان عن التقنية، فإن الذكاء الاصطناعي إضافة أصيلة في ترجيح توازنات القوى بين البشر والتكنولوجيا؛ كونه متفوقًا عليهم زمنيًا وتقنيًا، لامتلاكه القدرة على معالجة قدر هائل من البيانات في زمن قصير نسبيًا، مقارنة بالزمن الذي يحتاجه البشر لمعالجة الكمية نفسها من البيانات، إضافة إلى تأرجحه قانونيًا ضمن منطقة رمادية لم تحسم بعد.
في المقابل يحكم الاستخدام البشري للتكنولوجيا قواعد وقوانين معينة ترسم الكيفية الوحيدة التي يتخذ فيها القرار المتعلق باستخدامات معينة، خصوصًا تلك التي لها تأثير على حيوات أخرى بشرية أو حيوانية أو بيئية، وهذا ما يضع حدود المسؤولية للبت قانونيًا في عواقب تلك الاستخدامات إن لزم الأمر.
ناهيك عن أن الذكاء الاصطناعي ليس ذكاءً بالمعنى المجرد للكلمة، بل هو وسيط تكنولوجي يحمل رسالةً تتلخص في إنجاز مهام مكتوبة بخوارزميات معينة، فهو لا يتعب أو يُنهك، بل موجود لينجز، وإنجازه هو التعلم والاستنتاج المنطقي استنادًا إلى قاعدة بياناته التي يصممها له البشر.
الخطر الأكبر يتمثّل في نقل سلطة اتخاذ القرار من البشر إلى الخوارزميات
ليس الذكاء الاصطناعي مجرد برنامج محايد، بل هو منظومة ماديّة تحتوي على خوارزميات مكتوبة وفقًا لرؤية مَن صمّمها، وموجهة وفق تصوراته لما ينبغي تحقيقه على أرض الواقع. يحمل الذكاء الاصطناعي رغم حياديته الظاهرة مواقف ذاتية مضمرة، وتشخيصات مسبقة لما يعتبره عدوًا وملامح لما ينبغي تدميره. إذ يتم تغذيته ببيانات محددة، وفقًا لمرجعية مَن أعدها، وتنفيذها يتم على أساس قواعد مبرمجة سلفًا، تحدد هوية العدو، ومساحة الهدف، وطريقة التعامل معه.
الذكاء الاصطناعي العسكري
يعني هذا أن ماديّة الذكاء الاصطناعي ليست محايدةً على الإطلاق، بل محمّلة بالسياق السياسي، والثقافي، والجغرافي، الذي تحدده جهة البرمجة، وغالبًا ما يتم تطوير الذكاء الاصطناعي العسكري ليلائم طبيعة ساحة قتال محددة، ولائحة أهداف يتم إعدادها سلفًا وفقًا لبيانات تاريخية، وتحليلات مواقف سابقة، وتكتيكات عسكرية موروثة.
لكن الخطر الأكبر هنا يتمثّل في نقل سلطة القرار من الفرد البشري، صاحب المحكوم بالأخلاق، إلى خوارزميات محايدة ظاهريًا، موجهة في جوهرها، قادرة على اتخاذ قرارات مميتة دون أي اعتبار للبعد الإنساني. يصبح الذكاء الاصطناعي، على هذا النحو، المحرقة الرقمية، حيث يتم تبرير القتل تحت شعار "خطأ النظام"، دون محاكمة جهة مسؤولة، بل محاكمة تقنية تعتمد على نسب الاحتمال، وحسابات الجدوى، وكفاءة النتائج.
لا أدعو هنا إلى محاربة التكنولوجيا بحد ذاتها، بل ضرورة تطوير ميثاق أخلاقي يحكم استخدامها، وتوجيه الإعلام، على اختلاف مكوناته، نحو ساحة الحوار البنّاء، بدلًا من تركه ميدانًا للحرب وممرًا للاستغلال السياسي ومادة خامًا لإنتاج الشر على نحو مؤتمت.
يرتكز دور الإعلام، كما يرى أدورنو، على ضرورة إخضاع التقنيات الحديثة للنقاش والنقد، وتطوير نموذج تربوي يحذر من "التفكير المحرقي"، الذي يميل إلى استخدام الأدوات التقنية لفرض الهيمنة، وتعزيز ممارسات العنف، وتحويل الإعلام إلى محمل مادي للإبادة، يتم تبريره بلغة التنمية والتقدم.
المحاكمة الأخلاقية
نعيش عصرًا تتداخل فيه ماديّة الإعلام، وتقنية الذكاء الاصطناعي، وحرب القرار، على نحو غير مسبوق. أصبحت المساحة الفاصلة بين البشر وآلاتهم أصغر مما كانت يومًا، ويحمل كل قرار مبرمج إمكانية تقرير مصير حياة مئات، بل آلاف الأشخاص. من هنا، فإن الحديث عن مادية الإعلام، وحمولته التقنية، وأبعاده الثقافية، لم يعد ترفًا فكريًا، بل ضرورة أخلاقية عاجلة.
ليس المهم أن نمتلك التكنولوجيا، بل المهم ألا نسمح لها بامتلاكنا. ففي ماديّة الإعلام، كما في ماديّة المحرقة، تكمن رسالة بقاء البشرية، وضمان ألا تتكرر مآسي الماضي على نحو رقمي ومؤتمت، ليصبح القتل مجرد عملية مبرمجة على قائمة أهداف، دون محاكمة أخلاقية، أو صوت إنساني يقاوم الزوال.
الإعلام بكل مكوناته سلاح ذو حدين، وحامل لقوة الخلق كما لقوة الفناء، ومهمتنا، أفرادًا ومجتمعات، أن نكتب ميثاقًا أخلاقيًا يحكم ماديته، ويوجه حضوره نحو حياة البشر وحريتهم بدلًا من استخدامه ممرًا لإنتاج المحرقة على هيئة خوارزميات مبرمجة.