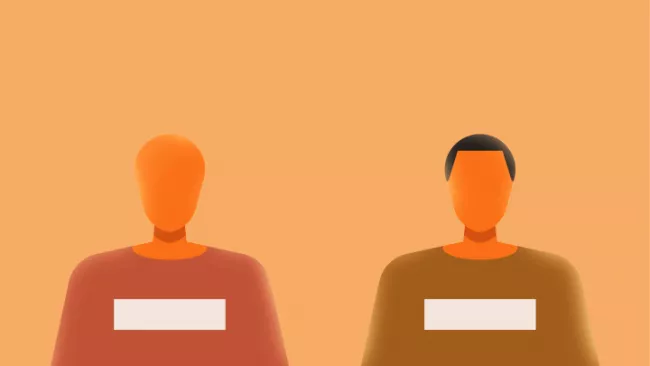افرجها علينا علينا علينا يا رب
عن معتقلي مصر وظلمٍ يرفض حتى سحقنا بأسمائنا
في عام 2014، وَقفْتُ ملصقًا أذني بنضارة باب زنزانتي في سجن استقبال طرة. بعد عام كامل من الحبس الاحتياطي بتهمة التجمهر ضد انقلاب يوليو/تموز 2013، نُقلت أنا وقضيتي من سجن المرج، حيث كنا القضية السياسية الوحيدة، إلى سجن استقبال طرة، للمحاكمة. كان طرة أول سجن نلتقي فيه سجناء سياسيين آخرين منذ بداية حبسنا في أكتوبر/تشرين الأول 2013. وقفت مشدوهًا، أُنصت للأنغام المتدفقة من فتحات الحديد.. هتافات، أغانٍ، سباب، ودعاء. بعد دقائق، سمعت صرخة تصدح من الدور الرابع:
"افرجها علينا علينا علينا علينا علينا يا رب".
في كل زنزانة طُفُت بها على مدار ست سنوات وثلاثة أشهر قضيتها في السجون، ظلت هذه الدعوة الشهيرة تنهال على أذني كالمطر. ولكني لم أصبح مسجونًا بحق حتى اعتليت بنفسي ذات ليلة منبر نضارة باب الزنزانة. منذ تلك الليلة، بت ألصق فمي بشبك النضارة كل مساء، أسحب نفسًا مِلْءَ الرئتين، ثم أصرخ؛ "افرجها علينا علينا علينا علينا علينا يا رب". أسمع صدى صيحتي الطويلة في حنايا العنبر، وردود الأصدقاء من زنزانة مجاورة "هتفرج.. هتفرج".
مبهورًا كنتُ بتركيبة تلك الدعوة وأنا أهمسها لنفسي قبل النوم على فرشتي. تأخذني جماعيتها: علينا، وليس عليَّ. ذاك الحرص على شمل كل الآذان المُلصقة بالنضارات، ألا تخطئهم الاستجابة. كأن صرخة "يا رب" من كلٍّ منا تنسلُّ من بين الحديد، تشعل "علينا" وأخواتَها الطافيات في هواء العنبر، تنفخ في بطن الدعوة فترتفع إلى آذان السماء.
أتساءل: لماذا التركيز على قلب الدعوة، لا طرفيها؟ لماذا ليست "افرجها افرجها افرجها" أو "يا رب يا رب يا رب"؟ لماذا وقع الاختيار على "علينا علينا علينا علينا" لتقربنا إلى تلك السماء التي تملك مفاتيح الأبواب؟
أين تذهب الحكايات التي لا نحكيها؟
منذ يوليو 2013، أصبحت السجون المصرية مقابر للأحياء؛ وظيفتها الأولى أن تمحو جثث مدفونيها من العالم.
60 ألف معتقل كلٌ منهم بات رقمًا مُبتَلَعًا في طيات إحصائية أو أخرى. من وقتها وحتى 2024، بلغ عدد الوفيات داخل السجون والمعتقلات 903. ليس موتًا طبيعيًا، بل قتل؛ من إهمال طبي متعمد، إلى حرمان من العلاج والأدوية، إلى الموت تحت وطأة التعذيب. وهناك من فارقوا الحياة بسبب الحر القاسي والتكدس داخل الزنازين.
لم يكن حتى الأطفال بعيدين عن البطش؛ اعتُقل أكثر من أربعة آلاف طفل بين عامي 2013 و2019، بعضهم لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره حين اقتُلِع من طفولته وزُجَّ به في زنزانة باردة.
في مصر هؤلاء هُم المحظوظون، المعلوم لهم وجود وعنوان، ممن لم تطلهم أنياب الإخفاء القسري. ابتلعت أجهزة الديكتاتورية العسكرية أكثر من 12865 روحًا من شوارع مصر ومنازلها، ليختفوا دون أثر. يسير أهاليهم في دهاليز بلا نهاية، يقدمون بلاغات، يطرقون أبواب المجلس القومي لحقوق الإنسان، يصرخون بحثًا عن أبنائهم بلا مجيب.
ها أنا أجترُّ الأرقام مرة أخرى. أخفيهم. أمحو وجوههم. أرتكب الجرم نفسه. أصب عليكم إحصاءات لا تعني شيئًا. 903، 4000، 12865، تهطل الأرقام حتى تتبلد، ككلمة تتكرر أمام المرآة حتى تفقد كل معنى.
دعوني أحكي لكم، إذًا، عن "جِيدا".
في عام 2015، نُقل شاب شرقاوي يُدعى عبد المجيد من المؤسسة العقابية إلى سجني بوادي النطرون. عبد المجيد، أو "جيدا" كما كنا ندلعه، محبوسٌ مُذ كان عمره 16 عامًا. بعد سنتين في المؤسسة العقابية، بلغ الثامنة عشرة، ليُرحَّل مع مجموعةٍ ممن لم يُتمموا تعليمهم الثانوي بعد.
كنت وقتها أنهيت دراسة سنة أولى هندسة داخل السجن، فتطوعت لمساعدتهم في المذاكرة ليتمكنوا من التقدم للامتحانات. صرت أذاكر لهم يوميًا في فترات التريض الصباحي، أشرح لهم اللغة العربية والإنجليزية ومعادلات الرياضيات والفيزياء والكيمياء. أجري وراء جِيدا في ساعة التريض، أجذب جسده النحيل للحصص جذبًا، فيضحك بعينين سوداوين تلمعان قبل أن يجلس متربعًا ليدرس.
بعد ترحيلي من وادي النطرون، علمت أن جيدا تقدم للامتحانات وحصل على شهادة الثانوية العامة، ثم التحق بكلية اللغات والترجمة. فرقتنا السجون، لكني اكتشفت بالصدفة قبل فترة قصيرة أنه لا يزال محبوسًا. صُدِمت وسألت؛ "متى اعتُقل مجددًا؟".
لم يغادر جيدا السجن من الأساس. فكلما انتهت قضية، أُعيد إلى مركز الشرطة في الشرقية ليواجه قضية جديدة، وهكذا يستمر في الدوران منذ عام 2013 لليوم. 11 عامًا كاملة منذ كان طفلًا في السادسة عشرة.
هذا هو كابوس التدوير في مصر؛ دوامة تحتفظ بمن يتم تنفيذ حكمه أو حتى يحالفه الحظ بإخلاء سبيل. يُحتجز المعتقل المُفرج عنه في قسم الشرطة الأقرب له، ثم تُدرجه وزارة الداخلية في قضية جديدة، ليظل يدور في حلقة مفرغة من اعتقال لا نهاية له.
يمر معظم من عرفتهم في تلك الفترة، من شتى المحافظات، بالمصير نفسه. لم يعد هناك ما يُسمى بالخروج. بين يناير/كانون الثاني 2016 ويناير 2023، خضع أكثر من 2914 معتقلًا سياسيًا للتدوير. في الشرقية وحدها، أعيد تدوير 228 سجينًا في 2023، رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل. ليس هذا هو أشد ما يؤلمني، بل كون من يراسلني منهم يتحدث عن الأمر كحقيقة راسخة، وكأنه تقبَّل أن الحياة خارج الجدران لم تُخلق من أجله.
توالت المذابح حتى أخمدت شوارع مصر، فبات الاعتقال وسُكنى السجون واقعًا لا يرتفع له حاجب ولا يهتز له قلب. بعد 11 عامًا من أحداث يوليو 2013، يُدرك المعتقلون وأهاليهم أن أحدًا لن يتوقف لأجسادهم المهشمة: واصل الأصدقاء الحياة، والأقارب إما مشغولون أو خائفون من التواصل. تجاوزهم العشاق، ووجد المدافعون والداعمون قضايا جديدة يدافعون عنها. مع مرور الوقت، أصبح المعتقل كأخبار الأمس، منسيًا، وحتى أحباؤه اعتادوا حقيقة أنه لم يعد من هذا العالم.
أحيانًا أتساءل.. لمَ يستمر العالم في الدوران؟ أين تذهب الحكايات التي لا نحكيها؟
حكَّ ظهري لأحكَّ ظهرك
معتقلو مصر ليسوا فقط مخفيين عن الأنظار، بل هم غائبون عن العالم بأسره. لسنين، كنا نجتمع في زنازيننا حول الراديوهات المهربة، نسترق السمع لأخبار الكوكب. لم يمر الكثير حتى أدركنا مكاننا كأعراض جانبية مقبولة ليستكمل العالم دورته. حتى قَهرُنا، لم يعد لافتًا ولا داميًا بما يكفي لجذب الانتباه في عالم لا يلتفت لنا كعرب إلا كجثث وأشلاء.
حزمة المساعدات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي للنظام المصري، بقيمة 7.4 مليار يورو، تذْكِرةٌ صارخةٌ بأن حياة المعتقلين السياسيين في مصر ما هي إلا عملة للتداول في سوق المصالح السياسية. لا يقتصر هذا الدعم على غض البصر عن عشرات الآلاف من السجناء المتكدسين في الزنازين المصرية لكبح جماح الهجرة، وضمان مصالح الاتحاد الأوروبي في المنطقة، بل يمنح الضوء الأخضر لاستمرار التنكيل.
الرسالة واضحة: ما دامت مصر تؤمِّن مصالح أوروبا، فإن الأخيرة لن تنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان، بل قد تتواطأ فيها.
لكن لنتحدث بصدق: أوروبا، بتاريخها الاستعماري واستغلالها المستمر للجنوب العالمي، وتواطؤ غالبية دولها مع الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، ليست في موقع أخلاقي يسمح لها بـ"غض الطرف" أو بسطه، وكأنها تملك أي سلطة أخلاقية على حقوق الإنسان. الحقيقة المُرّة هي أن الـ60 ألف سجين سياسي في مصر ليسوا إلا تفصيلة هامشية في علاقة تبادلية تخدم المصالح السياسية لأوروبا، وهذا يتسق تمامًا مع تاريخ وأخلاقيات أطراف هذه الصفقة.
وتأخذنا سيرة فلسطين نحو أكبر مثلث طُفَيلي بات معتقلو مصر ضحاياه المقبولين: الولايات المتحدة، النظام المصري، والاحتلال الإسرائيلي.
منذ 2013، أيُّ مرونة تبديها مصر بشأن حقوق الإنسان نتيجةَ الضغوط الأمريكية، هي مجردُ إجراءات سطحية تهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن. ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على تغيير مصير معتقلي مصر السياسيين، كون مصر ثالث أكبر متلقٍّ لمساعداتها العسكرية في العالم، إلا أنها لا تكترث سوى بالحفاظ على حليفها المطيع لتأمين موقع الاحتلال في المنطقة.
في عام 2021، عندما حجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات الأمنية بسبب السجناء السياسيين، وهو الحجب الذي رُفع لاحقًا، استجابت مصر بخطوات فارغة: إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، افتتاح مُجمع سجون "خمس نجوم"، الدعوة لحوار وطني، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي. لكن مع تصاعد الأحداث في فلسطين عام 2021 باقتحام الأقصى ثم قصف غزة، تراجع الضغط الدولي على مصر لتلعب دورها كرجل شرطة للنظام العالمي في المنطقة. مات الحديث عن لجنة العفو وغيرها، ونُحِِّيَ ملف المعتقلين عن الطاولة.
ثم جاءت الفضيحة في عام 2023 باكتشاف دور السيناتور الأمريكي بوب مينينديز كعميل للحكومة المصرية. أثارت الواقعة آمالًا مؤقتةً للنشطاء المصريين بتحريك ملف حقوق الإنسان والمعتقلين، ولو لحفظ ماء الأوجه.
هلت بعض البشارات: في رد تجاه تلك الفضيحة، حجب السيناتور بن كاردين المساعدات العسكرية عن مصر، مشيرًا إلى أن المساعدات المستقبلية ستعتمد على التحسن الحقيقي في حقوق الإنسان. لكن الإبادة الجماعية في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر رجَّت العالم وأعادت الأمور إلى نمطها المعتاد. انسلَّت مصر الرسمية لتبرز دورها كوسيط إقليمي رئيسي، مذكّرة الولايات المتحدة بأهمية ولائها في المنطقة. وعادت اللعبة "حك ظهري لأحك ظهرك". سهل لي سحق من بالداخل لأعينك في إبادة من بالجوار.
ليست هذه دعوة مني للولايات المتحدة ولا أوروبا لتكترثا بأي شيء، بل على العكس تمامًا. هذه إزالة لأي لبس بشأن من هو مجرد مقصر، ومن هو ناجح في دوره كجزار رئيسي في المنظومة العالمية المبنية على أشلائنا غير المسماة.
حتى خارج حدود بلدهم، يبقى معتقلو مصر ورقة تفاوض تُستخدم عند الحاجة، تفاصيل هامشية مقبولة لا يُكترث لها، يلصقون شفاههم بحديد النضارات، ينادون آذانًا صماء.
البحث عن مكانٍ على الألسنة
تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، صارت زيارات السجون عبئًا لا يحتمله أهالي أغلب معتقلي مصر. في طوابير الزيارة، دارت الأحاديث بين الأهالي عن استعدادهم لبذل أي تضحية ليعود أحباؤهم إلى أحضانهم. تحولت الأحاديث العفوية إلى رسائل نشروها على صفحاتهم الشخصية يؤكدون فيها قبولهم أي شروط تفرضها الدولة مقابل الإفراج عن أبنائهم.
مع ازدياد المناشدات، أُنشئت صفحة باسم مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين، وأُطلقت استمارة توقيع جمعت في غضون أسابيع قليلة 11425 توقيعًا. تخاطب المبادرة سجاني أبنائهم مباشرة: سمّوا شروطكم، افعلوا ما تريدون. فقط أخرجوا أحبّاءنا من السجون. دعونا نهنأ برؤيتهم قبل أن نموت.
منذ انطلاقها في 2 يوليو الماضي، تحولت المبادرة إلى صرخة أخيرة تطلقها حناجر أهالي السجناء السياسيين في مصر. حتى من يتأذى من صيغة المبادرة وخطابها الذي يتسول الحياة من الجلاد، لم يملك سوى دعمها.
يملؤني الأسى على انكسار أهالٍ أحذيتُهم برقاب سجانيهم، لكنني أفهم. أفهم ما يعنيه أن تصبح مخفيًا، بلا وجه ولا سيرة بين ستين ألف معتقل مصري في الداخل أو الخارج. أن يتحول جسدك المهشم إلى موضوع لم يعد مثيرًا بما يكفي. رقم ضمن أرقام تنهمر. أن تجد نفسك، مع كل هذا، حتى على الورق منازعًا في تسمية مظلمتك، فالموقف الرسمي لمصر ثابت لا يتزعزع: لا وجود لمعتقلين سياسيين هنا.
عندما لا تكون في عز قهرك حتى موجودًا، ماذا تفعل؟
تخرج كل حين وحين بعض القوائم المحدودة للتسويق أو بناء رصيد دولي، لكن في الوقت ذاته، يُعاد اعتقال المهندس يحيى حسين عبد الهادي بسبب كتاباته، ويُختطف رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر ويُزج به في الحبس الاحتياطي بتهم الإرهاب المعتادة التي خطها على وجه السجان بضربات فرشاته. هؤلاء هم القلة ممن مُنحوا أسامي وقصصًا.
أما عموم أهالي المعتقلين المجهولين فيتشبثون، رغم كل رسائل الإحباط، بالمبادرة كقشة الغريق. أرى كيف تمنحهم ما هو أكبر من الأمل المبعوث. تمنحهم المبادرة مكانًا على الألسنة، قناة ليبثوا خلالها أوجاعهم.
تُهدِيهِم، على الأقل، وجهًا.
ظلم يرفض حتى أن يُسمِّيك
يرسل لي صديقي أيمن موسى رسالة من السجن يقول فيها "ما المشكلة في الموت؟ لعل فيه الخلاص".
لا أعلم كيف أجيبه. صديقي أيمن يتم سنته الحادية عشرة في السجن لأجل مظاهرة حضرها وهو في التاسعة عشرة. التهم السجن عشريناته بأكملها. قبل أسابيع من عيد ميلاده الحادي والثلاثين، ما الذي يمكنني منحه إياه؟ أملًا قد يقتله أم يأسًا قد يقتله؟ أم صمتًا يتركه ليموت في صمت؟
لسنوات، كنت أعتقد أن الإهانة المتعمدة هي أسوأ ما يمكن لجسدٍ أن يتحمله. تلك الصفعة التي تهز جمجمتك، الموجهة إلى وجهك تحديدًا دون سواك، وأنت تقف عينًا بعين مع جلادك؛ اليد التي تتحسس أعضاءك التناسلية بذريعة التفتيش، الابتسامة الساخرة التي تتلذذ بكل لمسة؛ رأسك التي ترتطم بأسمنت الجدران في تشريفة كل سجن جديد.
مع مرور سنوات السجن، تعلمت أن هناك مستوى من القهر لا يدركه الإنسان حتى يتذوق كون جسده عَرَضًا جانبيًا. أن تقف لتنهال عليك اللكمات ليس لإخراسك، بل لإخراس المتفرجين. أضلاعك المكسورة تصبح رسالة تحذير للآخرين لئلا يفتحوا أفواههم. لحمك خشبة مسرح، كدماتك مسرحية تعرض لجمهور لست من ضمنه. معاناةٌ تصبح فيها أنت العنصر الأكثر تهميشًا، ظلمٌ يرفض حتى أن يُسَمِّيَك.
أكتب لأيمن "هل سمعت عن حفلة ويجز الجديدة؟ كايروكي قادمون للولايات المتحدة. أفكر بالسفر لحضور حفلتهم في نيويورك. كيف كانت رواية أشرف العشماوي التي أخبرتني أمك أنك بدأت بقراءتها؟"، أحاول أن أطعمه شيئًا من الحياة التي سُرقت منه، بدلًا من تسمية الشر الذي يرفض منحه وأمثاله اسمًا.
أفهم الآن، بعد سنين، لماذا تُكرّر من الدعوة قلبها، لا الأطراف. افرجها علينا علينا علينا علينا علينا يا رب. انظر إلينا يا الله. يا عالمُ، سمِّنا. الله واحدٌ والفرج معلومٌ بالضرورة، أما نحن فنُدهس من شر يرفض حتى أن يسحقنا بالاسم.
بكل عجزنا، أدعو للتسمية. لعدم الاعتياد. لنزع اللثام الذي يكتم أنفاس المقهورين قسرًا. إن لم يكن بيدنا قوة لرفع الظلم كله، لنكن حجر عثرة يعوق تمام الإزالة. أحيانًا، لا نملك سوى خيوط ضوء مزعجة، نسلطها عليهم، عليهم، عليهم، عليهم.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.