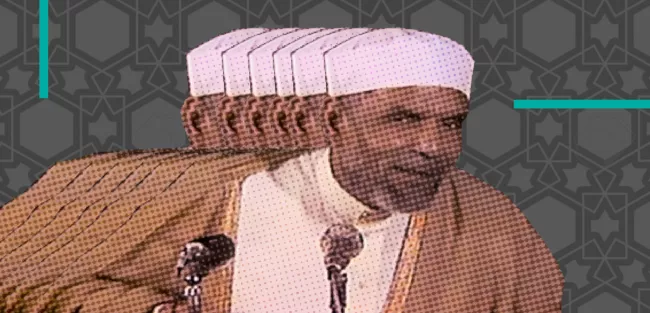روبي التي لا تحبها سلطة الإسلاميين والجنرالات
تبدو الكتابة عن روبي في اللحظة الراهنة مثل سردية من الماضي، أفل نورها عندما أصبح المجتمع أكثر حدة. مضى زمن وحدَّ عبد الوهاب المسيري وعبد المنعم أبو الفتوح وأيمن نور مع حمدين صباحي وكمال خليل على مطلب واحد؛ كفاية. تحقق المطلب بعد حين، ثم ارتدت الأمور فلم يبقَ من الحرية إلا اسمها، لم تتحقق العدالة بعد سفك دماء كثيرة، رايات الوطن ترفرف بفعل هواء يتحكم في نسماته بونابرت جديد، نتنفس الهزيمة مثل خطايا قديمة توجب على مرتكبيها دفع أثمان من عمر تقصفه ثلوج المنافي وعطن أقبية المعتقلات وحبال تتدلى من أسقف غرف تدل على نهاية لم تكن محتومة لشاب أو فتاة في ربيع العمر، تواريخ ضائعة من قصص دامية محمّلة ببعض الذكريات.
لكن كيف نواجه عسف السلطة بأيادٍ عزلاء وقلوب مكلومة؟ ربما باستدعاء الماضي القريب؛ عندما كانت الأحلام طيعة، أو هكذا كنا نظن. أو بالهجرة إلى ذوات ما زالت معلقة بأهداب الحلم، إلى المستقبل البعيد حيث الحكايات لم تفقد سحرها بعد أو استعادت بريقها القديم، والاستقطابات لم تبقنا وحدنا للأبد، نعاني الهشاشة والحنين ونبحر إلى أعماق اليأس، نستند على قدم واحدة مثلما يمشى الحاضر الأعرج بالضبط، نحجل كجندي مسكين تخلى عن إحدى قدميه حفاظا على باقي جسده من الغرغرينا، لم يمت، لكن روحه لم تعد بخير.
ميريت آمون أم نفرتيتي؟
قرأت في عدد قديم من الآداب البيروتية شهادة لصنع الله إبراهيم عندما كان أديبًا شابًا. يقول إنه خرج من السجن ضائعًا في الستينيات، يبحث عن عمل وعن امرأة. أحببت تلك الصراحة الجارحة، وكنت مثله ضائعًا ووحيدًا. اختلفت أقدارنا، لم أطأ أرض المعتقلات، ولعلّي لا أدخلها أبدا يا الله، لكننى كنت في حالة شبيهة في أول الألفية الجديدة، أدرس في جامعة إقليمية لا أحبها وكلية أمقتها لكنها تحاصرني في كل مكان مثل كتابات إحسان عبد القدوس.
أبحث عن كتاب جيد وعن فتاة تروض طوفان رغبة مزلزلة في قلب شاب، يحمل انحيازات مزمنة مثل الأمراض العصابية لا تزول أبدًا وتوهمات صوفية تثقل القلب بتطلعات غنوصية إلى ما وراء تلك الآفاق البعيدة، حيث الرؤى تدور وتدور، وتهبط الرسالات على رؤوس المؤمنين الأوائل بالمقولات الكبرى. انغمس في القراءة حتى تدمي عيناي، فالقراءة مثل البكاء عسيرة ومزمنة، مثل تعاطي عقاقير الاكتئاب. عثرت على متع صغيرة مختلسة هنا وهناك مع رفاق سوء حقراء حينًا ونبلاء أحيانًا.
إلى أن وجدت روبي ذات مساء تحت سقف يجمع طلابًا متوسطي الحال وعمالًا فقراء، نفكر وندخن ونشرب، ماذا يعوزنا أكثر من ذلك؟ لا يعوزنا شيء أيها الرب سوى ثورة ظافرة، أرسِلها لنا ولك الحمد.
على شاشة تضع أمام عيني عالمًا لا أعرفه وأحيانًا كنت أعاديه، رأيتها، كانت تتهادي في شارع غريب بملابس رقص، غَرِقت في الملامح المصرية، القسمات واللون والروح، أتكون ميريت آمون أم نفرتيتي؟ لم انتبه إلى تعليق رفيقي القريب إلى قلبي الذي كان وقتها يكتب شعرًا عاميًا جميلًا على الأغنية التالية للبنانية إليسا، لكزني في جنبي "الست دي دمها أتقل من ضهر أغسطس". قالها وهو ينفث دخانًا كثيفًا من سيجارته نحو الشاشة، حتى غاب جسد وثديا إليسا عن ناظري وسط موجة معتمة من الدخان.
وليمة للتهتك
ظهرت روبي في الوقت المثالي، ربما لذلك ما زالت حاضرة في زمن الغيابات المتعمدة. لم تكن هتافات طلاب جامعة الأزهر قد خفتت أصواتها بعد، مع نهايات القرن الماضي، وهي تطالب برأس الروائي السوري حيدر حيدر بسبب روايته وليمة لأعشاب البحر وبطلتها الماجنة فلة بوعناب ضحية الوحول الأيديولوجية في مرحلة التحرر الوطني وحروب التحرير، ولا خرست ضوضاء جماعة الإخوان وعضوها في البرلمان عن محافظة البحيرة جمال حشمت (أين نهى الزيني؟) عن ثلاث روايات مصرية بدعاوى نشرها "الفسق" في أول الألفية الجديدة، ولا كف الأقباط عن الصياح في الكاتدرائية، بصورة بدت شهرية، يطالبون مرة بإيقاف عرض الفيلم الجميل بحب السيما للراحل أسامة فوزي، وأخرى يطلبون عون الأسد المرقسي، بقيادة حارس حياض الصليب نجيب جبرائيل، لاستعادة وفاء قسطنطين الخارجة -بإرادتها- عن حظيرة الرب وعرش النعمة، بينما المتنيح الأنبا بيشوي يشدد على السيدات والفتيات بدخول القداديس بـ"ملابس محتشمة". أهلا بكم في عصر السموات المفتوحة بالتعريف المصري.
كان بائعو الهراء ممن عرفوا إعلاميا بـ"الدعاة الجدد" يستولون على أراضٍ محروقة في وجدان الطبقة المخملية من سدنة الاستبداد (الأوليجاركية بالتعريف السياسي أو أسفل السافلين كما يصفهم الكواكبي)؛ وصلت إلى قصور صناع القرار وبيوت الفنانين، فيما كان نظراؤهم الشعبيون محمد حسان وحسين يعقوب وغيرهما قد فرضوا قوانين الوهابية على وجدان الطبقات الكادحة دون مقاومة تذكر، بعد أن عبّد الطريق الوعر سلفهم السلطوي المكرس محمد متولي الشعراوي.
اقرأ أيضًا: الشيخ الشعراوي.. من قبره يحكم الجماهير
حتى في السينما، ظهر مذيع الأطفال أحمد حلمي وجيل جديد من المضحكين يرفعون شعار "السينما النظيفة"، وكان على المصريين دخول القرن الجديد وأن يختاروا في الوقت نفسه بين عادل إمام (مع يوسف معاطي) ونادية الجندي وجيلهما الناجي من سينما المقاولات من جهة، ومن أخرى اللمبي وهنيدي وأحمد السقا وأفلامهم النظيفة للغاية.
مثل قنبلة عنقودية ظهرت روبي لتنفجر في وجوه الجميع، في ساحة مكتظة بالمحافطين وحراس قيم المجتمع المؤسسة على القمع والنهب وإفقار الناس والتواطؤ على علمنة وتمدين الطبقات البرجوازية وتديين وترييف البروليتاريا وأبناء الشقاء الأبدي. تطايرت أشلاء اللحى الطويلة أو الفضيلة المزعومة تطلب ثأرًا من فتاة تخطت لتوها عتبة المراهقة.
لقد أهانت صغيرة بجسد نصف عار، دون أن تدري، عملهم طوال أكثر من ربع قرن في ترويج الإرهاب والضرب بالجنازير والأسلحة البيضاء في صعيد مصر، والاغتيال الجسدي الإجرامي لفرج فودة وغيره، والمعنوي -الإجرامي أيضا- لنصر حامد أبوزيد. عبّرت هذه الصغيرة عن حرية مجتمع يتململ من محاولات جمة، مدعومة بسلطة الرأسمال النفطي الهائل، لفرض نمط حياة صحراوي، فيما كانت الدولة بأذرعها الطويلة والمتوحشة مثل منابر ومذابح التطرف في المؤسسة الدينية الرسمية، تجهل من أين ظهرت تلك الفتاة المتهتكة التي ترقص في الشوارع دون حياء.
المثقف والجسد
قضى الباحث الراحل عبد الوهاب المسيرى عمره متأرجحا بين اليمين واليسار، مثل غيره من المتنقلين بين ضفتي الأفكار الراديكالية التي سيطرت على العالم العربي منتصف القرن الماضي، قبل تهاويه الأخير يمينًا. ربما كان أهمهم، لامعًا وسط "فواعلية العمل الذهني"، بتعبير سليمان فياض الأثير في وصف الشغيلة من الأدباء والكتاب. غابت تلك الأزمنة وأفضت حتميتها إلى رميم أيديولوجي يتنابذه أشقياء منشقون في صحف تفوح منها روائح الاحتراق.
انزعج المسيري من روبي، فكتب مقالا طويلا في الأهرام، حاول فيه تحليل وتفكيك الظاهرة من كل جوانبها، أو بالأحرى من كل عريها، انشغل بـ"كده" اللعوب مع غمزة العين الفاجرة، التي تختتم بها أغنية "ليه بيداري كده"، بدا مهموما وهو في آخر سنواته بتهتك المجتمع، رحمه الله قبل أن يشاهد مجون التيك توك والرقص المتواصل ليل نهار، وأين؟ في ما تخوف وحذر منه، في صالة المنزل يا سيد عبد الوهاب.
إنه زمن الانحلال القادم من الشرق، حيث الصين والطرق الوعرة للتنمية لا من الغرب وتهافت بروباجندا الاستعمار القديم في صورته الإمبريالية التي ظل الرجل يشير إلى كل أشكالها طوال عمره، يساريًا أو إسلامويًا. أحال المسيري قارئه إلى رصانة وإيجابية سعاد حسني في "كدهوه" التي تعبر عن انتزاع الحق، كما قال، مقارنة بـ"كده" المومسية عند روبي، تحدث بالتحديد عن "زوزو"، الفيلم الذي نال جرعة نقد مكثفة من الإسلاميين حتى اليساريين؛ "بمبي يا صلاح".
ربما بعد ثلاثين عاما يقرأ محبو الفنون دفاعًا مستميتًا عن سارة سلامة بوصفها معبرة عن رصانة جيل ما بعد الألفية في مواجهة انحلال أجيال منتصف القرن الواحد والعشرين. إنها صيرورة مستمرة وتطبيع متواصل مع التخفف من الملابس، سنعود إلى صورتنا الأولى كما خُلق أصل سلالتنا أول مرة في الفردوس الضائع، أو مثل القردة، في نظرية أخرى للنشوء، يغطينا زغب أجسادنا.
لم أجد في حديث السبعينيين عن سعاد حسني ما يجعلني أقع في غرامها أبدا، ربما أسرفوا على أنفسهم وعلينا، فنانة جميلة تفتن أسرى المجتمع المغلق على النساء في حرملك أبدي مذهب بالأخلاقيات الحميدة والحب العذري، ليس أكثر من ذلك، نادية لطفى أيقونية عن سعاد، وعلى مستوىً آخر شادية أيضًا، وما يجري على سعاد ينطبق بحذافيره على فاتن حمامة.
ما كان جديرًا بالتأمل، شغف إدوارد سعيد بالسيدة تحية كاريوكا وازدراؤه المغني المسكين عبدالعزيز محمود عندما شاهدها ترقص في أحد كازينوهات الزمالك في أربعينيات القرن الماضى، ولقاؤه بها بعدما تقدمت في السن وغدت "الحاجة تحية"، وحديثه عن استغلال زوجها المسرحي فايز حلاوة. يا لها من امرأة كما وصفها، ويا له من كاتب كما أصفه.
ربما ما يجعلني أجد وجاهة في فتنته بها، رغم أنها ليست فاتنة الجمال، عملها السياسي وقوة شخصيتها في زمن كانت المرأة منذورة للعبودية من الرجل والعائلة على طريقة القرون الوسطى، فيما ظل السؤال يراودني عن حال إدوارد لو شاهد روبي، بالطبع سيكون رأيه مغايرا للشاعر أحمد فؤاد نجم، ورده شديد السوء عندما سئل عنها.
ماذا تفعل "الحرة" مع حلمي بكر؟
بدأت صناعة الكاسيت في الانهيار مطلع الألفية الجديدة، بدا أن الزمن يتهيأ لنجوم جدد، تواكب أفكارهم ثورة المعرفة المتزامنة مع بدء انتشار الإنترنت، وتعوض خسائر المنتجين من ركود طال صناعة الموسيقى، ما حدا بهم إلى الاتجاه إلى الفيديو كليب كبديل عن الشريط التقليدي.
في البدء ظهرت نانسي عجرم، على قنوات صنعت خصيصا لبث الأغاني المصورة، مقدمة لطوفان غنائي جرف أسماءً قديمةً مهمةً وأجبرها عن التعاطي مع حداثة فنية عمادها الرئيس الصورة والاستعراض. قائمة طويلة من اللبنانيات احتللن الشاشات العربية؛ هيفاء وهبي ومريام فارس وإليسا وغيرهن، وفي مصر ظهرت بعض الأسماء أبرزهن شيرين عبدالوهاب وروبي كـ"صناعة محلية، لا أب لبناني ولا أم إيطالية، بل أن أمها كانت مدرسة ألعاب في مدرسة فتحية بهيج الإعدادية بعابدين" كما وصفها البراء أشرف في مقال ممتع.
بعد أغنيتها الثانية ليه بيداري كده والمشهد الخالد في ذاكرة مراهقى تلك الفترة للدراجة الشهيرة، تقدمت الحشود مطالبة برأسها على مذبح الفضيلة، كان المجتمع (بعيدًا عن النخبة المثقفة المخملية) خاملًا استسلم دون مقاومة لـ"بائعي الهراء" بقيادة الرجل الضليع في علوم التنمية البشرية والترهات عمرو خالد، بدا الأمر وكأننا مقبلون على ثمانينيات جديدة، حيث تتدفق الأموال على حسابات الفنانات البنكية مقابل ما أسموه التوبة.
"استشيخ" أحمد الفيشاوى، وترك لنا السيدة والدته سمية الألفى تكتب مقالات (آه والله) في جريدة العربي تصرخ وتلطم وتسب المجتمع بالكامل لأنه أظهر التضامن مع هند الحناوي و"ابنتها" لينا ضد طفلها المدلل الذي تخلى عن طفلته في قضية رائدة من ذلك النوع في مصر، سيناريو اعتزال الفيشاوي الصغير شبيه بما حدث في حالة محسن محيي الدين، لولا لطف الله وجنون الفيشاوي بالفن، خسارة ممثل جيد بدعاوى متهافتة تشبه عدوانًا ماضويًا على مواريث الحضارة.
ظهرت روبي في ذلك الزمن، عندما كان مصطفى بكرى يمثل دور المناضل المغوار، ويكتسب شعبيةً لا يستحقها، ورفعت السعيد يدبج المقالات والكتب في هجاء حسن البنا وسيد قطب وينشر مذكراته في مطابع فاروق حسني ويرفع رايات الماركسية في مجلس المناضل الأممي المعروف بـ "الأستاذ موافي" وهو اِسمه الكودي في أوساط عاملات الجنس. لم ينبرِ للدفاع عنها بشكل حقيقي سوى جريدة عادل حمودة، لا أذكر أكانت صوت الأمة أم الفجر، حيث قرأت مقالًا لـ سحر الجعارة لا يزال عنوانه في ذاكرتي "روبي الحرة"، كان حمودة يقدم كعادته صحافة نصف صفراء، لكنه كان يجمع كتابا جيدين في ذلك الوقت.
كان السياق معاديًا لروبي على المستوى الفني، بعيدًا عن مواقف سمية الألفى، يكفى أن الملحن القصاب حلمي بكر كان في عنفوانه واعتبر نفسه (مع صحف الحكومة) جنديًا في حملة جهاد مقدسة ضد ما أسماه الإعلام وقتها مغنيات التعري، معظمهن لبنانيات، وفي المقدمة والمصرية البارزة بينهن، كانت روبي، لم تجد من يدافع عنها سوى نفر قليل في مجتمع رضع الهزائم وأدمن الاختباء من كثرة ما تعرض لصفعات الزمن.
منذ أن وعيت على ما يحدث حولي وأنا أتعامل مع حلمي بكر ومرتضى منصور وثالثهم الراحل طلعت السادات، على أنهم امتداد عصري وفج لفن المنولوج أو ربما وجه العملة الرديء منه، اسكتشات مضحكة يقدمها الثلاثي كل على حده بموهبة فريدة عمادها البذاءة وقلة القيمة دون تمثيل أو زيف، كل منهم يعبر عن فكرة منهارة تقاوم هزيمتها بالكثير من التحرش بالودعاء الطيبين الذين سيرثون الأرض، في ظن أمل دنقل مستندًا إلى المسيح.
لقد أدركوا في لحظة إشراق حقيقية ونادرة بالنسبة لهم أنهم وما يمثلونه باتوا خلف ظهر العالم والمجتمع، وأنهم محض تنويعات رديئة على أنماط قديمة انقرضت من البشر والأفكار، فأعلنوا الحرب بلا هوادة على ما عداهم في محاولة أخيرة للوجود، ولو بالسلب، قبل احتضارهم النهائي.
حلمي بكر مثل كثيرين في مصر، بنى مجده على أشياء قليلة صارت باهتة بمرور الزمن، ربما كانت جميلة في وقتها، ثم نضب فنيا، قدم ما لديه ولم يعد يملك سوى الماضي، وكان يجدر به العيش مع الذكريات وقضاء شيخوخة مريحة وهانئة، لكن الرجل اختار طريقا آخر، يبقيه في قلب المشهد، استل سيفا من خشب وبدأ في طعن كل من يقابله، هو لا يقتل ولا حتى يصيب، مع ذلك يواصل الطعن بشراسة مثيرة للدهشة، ذاته كـ"ملحن كبير" لا تريد الاستسلام وتدفعه إلى خوض معارك سيزيفية دون طائل غير ملء ساعات البث لوائل الإبراشي وغيره، واقتناص ضحكات من مشاهدين على بذاءات مبتكرة من قاموس متجدد لا ينضب أبدا، حتى صار ماركة مسجلة باسمه.
أنقذيني من الإسلاميين والجنرالات
استعنت بروبي في واقعتين بعيدتي الأثر، طيفان غابران من أزمنة قديمة تواريا في تلافيف الذاكرة المزدحمة بهموم شتى، كأننى كنت أطلب مددا من قوى مجهولة ولم أجد شيئا قريبا منى ينقذني من التورط والخوف سوى ذكر تلك الفتاة السمراء، استعيدهما الآن كذكرى أيام ولت، لا أكرههما لكن لا أريدهما أن يعودا.
الأول عندما دعاني أحد الطلاب المتدينين المهذبين إلى لقاء مع بعض أصدقائه في مسكنه، ذهبت على أمل العثور على معارف جدد في مدينة فرعونية خلت فجأة من الأشياء التي أحبها عدا طيف ميريت آمون، للوهلة الأولى عرفت أنني في ملتقى يضم شبابا إسلاميين، جلست خجولا استمع ثم تشاركنا الحديث عن أبو الحسن الأشعري وواصل بن عطاء، تيقنت من أحاديث الشباب أنني وسط خلية وأنني قد أكون عضوا محتملا، لم أظهر رأيًا يزعجهم.
عندما حان وقت الانصراف أصر الصديق أن يوصلني إلى حيث موقف السيارات، سألني عن رأيي في "الجماعة اللي فوق"، قلت رأيا إيجابيا، ثم صمت، سألني مجددا عن شرودي، قلت دون تفكير "بفكر في بنت شوفتها في أغنية راكبه عجلة، رقصها عجبني، اسمها روبي، اسمها حلو، مش كده؟"، فهم على الفور ما أردت أن أخبره دون تصريح، ربت على كتفي مبتسما وقال "لا.. مش كده، ربنا يهديك".
لم أقابله بعدها إلا مرة واحدة مصادفة في أروقة جامعة لا أدخلها إلا مضطرا، فرقتنا الانحيازات للأبد، عرفت بعدها أنه غادر إلى الإسكندرية واستقر نهائيا على شاطئ المتوسط، ومن سنوات علمت أنه أصيب برصاصة غادرة في الكتف وقت الانتفاضة، ثم اعتقل في اعتصام إسلاموي بعد إطاحة الرئيس الراحل، فك الله كربه ورده سالما إلى أبنائه.
الطيف الثاني كنت أدفع فيه ضريبة الدم، عثروا بشكل ما على شيء يدينني، كانت المياه تجري في مجراها الطبيعي ومرت ستة أشهر دون عناء، لكنني بسذاجة مفرطة كنت قد طلبت من شخص أحمق في الكانتين أن يجعلنا نشاهد قناة الجزيرة، كنا في عام 2006 العاصف مشفوعا بما حدث في السنة السابقة 2005؛ انتخابات مبارك وأيمن نور ونعمان جمعة، أحداث إرهابية في سيناء والحسين، فتن طائفية في سيدي بشر بالإسكندرية، وحرب تموز الظافرة في لبنان. أتابع الأخبار بصفة مستمرة بالاستماع إلى إذاعات الراديو الأجنبية، وأيضا من دستور إبراهيم عيسى وكرامة حمدين صباحي، يغامر صديقي السكندري الجميل "ريمون" بإدخالهما لي خلسة بعيدا عن أعين الرقباء.
الأحمق رفض بالطبع أن يحرك مؤشر الريموت إلى الجزيرة ويبدو أيضا أنه أبلغ عني أو ربما فعل غيره، من الإسكندرية حيث أجبر على تمارين اللياقة والزحف وقد صرت ممشوق القوام ومفتول العضلات، أنا الكسول مثل إعرابي تعود أن يطوح قدميه أمام الخيمة ويدخن ويتثاءب دون داع قتلا للملل، أرسلوني إلى القاهرة بخطاب رسمي إلى مبنى موحش في مدينة نصر أمام دار سينما شهيرة، وصلت القاهرة مساءً مرتاعًا وحزينًا، قابلت صديقي الصحفي ماهر عبد الواحد في مقهى التكعيبة وكان معه صحفى آخر، أطلعت ماهر على الخطاب، هدأ من روعي، استكانت روحي مع فنجان قهوة وسيجارة، ماذا سيفعلون معي؟ لا شيء، لست مهما ولا أفعل ما يزعج أي شخص، في الواقع في تلك الفترة لم أكن أفعل سوى الشرود والاستماع مرارا وتكرارا لأغنية من تأليف الأبنودي غناها مروان خوري في فيلم أوقات فراغ، تعبر عن الضياع، لقد عشت جل عمري ضائعا مثل مجايليي، نبحث عن شيء غريب ومهجور، عن الحرية بوصفها تمثيلا للذات المتمردة.
أمضيت الليل مع ماهر، وفي اليوم التالي قضيت ساعات مرهقة في الانتظار قبل الدخول إلى غرفة كئيبة، كان المحقق قاسيا وشريرا، أو هكذا أراد إظهار نفسه أمامي، أجبت على كل أسئلته بأكاذيب صريحة، حتى سألني عن ما أشاهده في التلفزيون، قلت على الفور بصدق طفولي "روبي على قناة مزيكا".
زمجر الضابط مثل كلبٍ ضارٍ تلقى طعنة قرب القلب "نعم يا روح أمك؟". لم أجد في غضبته أي إهانة، فأنا بالفعل روح أمي وهى روحي، وهو أيضا روح أمه لو كان سويا وكانت أمه سوية مثل باقي الأمهات، ولا أعلم لماذا أزعجته سيرة روبي، ربما تخيل أنني أخدعه أو بعقله المحافظ رأى أن مجرد ذكرها وسط حديث جاد مثل السخرية، في النهاية خرجت وفي روحي طاقة غضب تكفى إحراق نصف العالم، اللعنة على المتجبرين.
في اليوم الثاني حُقق معي في أبي قير بالإسكندرية، وفي الثالث برأس التين، حيث أبحر يخت المحروسة بفاروق إلى بلد جرامشي وبطل طفولتي روبرتو باجيو، ومن البقعة نفسها انهارت أول يقينياتي، أنا في الثانية والعشرين من عمري، لم ارتكب أي جريمة أو حتى خطأ صغير ومع ذلك أزعجوني كمسجل خطر وأهدروا وقتهم معي، مثل بطل كافكا السوداوي شعرت بالعالم موحشًا ومقبضًا وحادًا مثل مشرط جراح معدوم الضمير يتاجر في الأعضاء البشرية، ربما من وقتذاك استوطنت الحدة روحي وتشربت القسوة كنبيذ ضروري للدفء من ثلج أحاط جسدي وجمد أوصالي، كيف يمكن (أو ترضى) أن تعيش مثل حمل في غابة من الضواري؟
حليق الشعر واللحية أخب في ملابس بحرية واسعة عليَّ ومضحكة، أتشعلق في سيارات الأجرة بين محافظتين، راتبي الشهري الممنوح لي من "الدولة الوحش"، بتعبير عفيفي مطر، 56 جنيها ولا يكفي أرخص أنواع السجائر التي كنت أدخنها آنذاك سوبر كليوباترا، في رأس التين مثل أبو قير مثل مدينة نصر، كانت الأسئلة نفسها وإجابتي ذاتها بما فيها روبي، سيغتالونني بالملل ولم أجد من بين أصدقائي من يكتب عن "الحسين شهيدا".
الضابط في المقابلة الأخيرة كان صغير السن، يكبرني بسنوات قليلة، ولطيفا على غير العادة، لدرجة أنه أخبرني أنه يحب مشاهدة روبي أحيانا، وانتهى الأمر بأن طلب مني وديا عدم الظهور في الكانتين أو المسجد، والتوقيع على إقرار رسمي بعدم ممارسة العمل السياسي طوال الستة أشهر المتبقية من خدمتي، كنت سعيدا لأن الأمر قد انقضى قبل أن أموت اختناقا من السأم، وأيضا بسبب أسلوبه المهذب ولأن الإقرار لم يشمل روبي، لكن كيف أشاهدها بعيدا عن الكانتين في أيامي القاحلة؟
التكريس مقابل التمرد
خرجت روبي من بيت طاعة مكتشفها شريف صبري، عانت للدخول إلى نقابة الموسيقيين، قدمت أغان لعبت على الوتر نفسه، رقصت نصف عارية متحدية الجميع وأجبرت الدولة على الاعتراف بها حتى ظهرت في برنامج نظام مبارك شبه الرسمي البيت بيتك، ومن ثم، وبالتبعية، حدث ما كان يخشاه عبد الوهاب المسيري وطبع المجتمع العلاقات معها، وفي التمثيل ظهرت بصورة جيدة مع وحيد حامد ومحمد ياسين في الوعد، وقبله مع يوسف شاهين في فيلم سقط من ذاكرة محبي الأستاذ سكوت ح نصور، ومع محمد أمين في ظهور خجول في فيلم ثقافي، ما سبق ملخص عشرية روبي الأولى، قبل أن تدخل إلى عشر سنوات جديدة كنجمة مرموقة وتبدأ تفقد رويدا رويدا صورتها القديمة كخارجة عن أعراف القبيلة.
لم يصادفني أي موقف أو رأي سياسي لروبي، انتفاضات وحرائق وهى صامتة كأنها في بلد آخر، أحد أصدقائي في الجريدة من صحفيي الفن، أخبرني أن روبي "طيبة للغاية"، في الحقيقة هو وصفها بأنها شبه ساذجة ولا تنشغل بأشياء معقدة وثقيلة على الروح مثل السياسة والثوارت وغيرها.
بعد سنوات من بداية تسببت في عاصفة من النقد صارت فنانة مكرسة، أفلت في قلبي مذ ذاك، رأيتها في حلقة مع ثقيلة الظل إسعاد يونس، الشهيرة بأهم أدوارها "زغلول"، المرأة التى استولت على جزء من أرشيف السينما المصرية مع زوجها رجل الأعمال متعدد الجنسيات (أردني من أصل فلسطيني يحمل الجنسية اللبنانية) علاء الخواجة ومن ثم بيعه إلى الوليد ين طلال (أين تاريخنا الفني يا إسعاد؟).
كانت أول مرة أشاهد روبي تتحدث في لقاء تلفزيوني، أجهدت نفسي وفتشت داخل روحى عن شيء قديم لم يفارقني أبدا، لم أجد غير صورة متخيلة لكنها ليست حقيقية، "أم طيبة" فقدت نصف بريقها في قلبي في تلك الليلة، أدركت أن التمرد هو ما صنع منها تلك الصورة القديمة الآفلة، ومؤخرًا قبل تفشي الوباء كنت أشاهد مباراة كرة قدم على قناة خليجية ورأيتها بين الشوطين ترتدى فستانا طويلا ولامعا، مثل الممثلات الجميلات قليلات الموهبة اللاتي يتزوجن رجال الأعمال، تشكو الجوع أو ربما شيئًا من هذا القبيل في إعلان معجنات مع ممثلين آخرين، ما هذا؟
ربما تأتي أجيال لاحقة وتقول إن روبي كانت فتاة عادية أو حتى أقل من ذلك، وكنا نحن في مطلع الألفية الثالثة مسرفين على أنفسنا وغيرنا، مثل السبعينيين بالضبط، خلبت ألبابنا برقصة وسط ثعابين وامتطاء دراجة وضحكة ماجنة مع لوسي في الوعد. ربما، ليكن ما يكون، لكن ما سيبقى للأبد، تلك البساتين التي زرعتها بالحرية في قلوب جيل كامل، تفتحت ورودها وخرجت خجلة ترقب الشمس وتستقبل ندى الصباح، ثم صعدت للفضاء غير مقيدة إلا بذاتها وأحلامها، حلقت مثل أسراب طيور مهاجرة، تركت وراءها أسوارا عالية كانت تحجب النور وتجبرنا على الحياة في العتمة، ثم كان الطوفان.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.