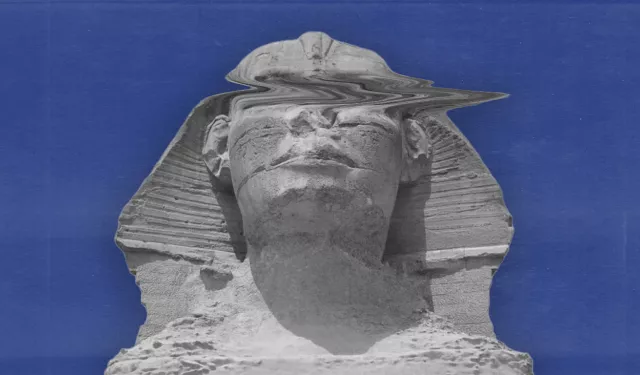
الماضي.. حكايات وحجر وإلهام
مع أي حدث استثنائي يخص أحد مكونات الهوية المصرية، كافتتاح المتحف المصري الكبير، تعود لتستيقظ تلك النزعة القومية بقوة، معها يستيقظ معارضوها، وتعم وسائط حياتنا اليومية مشاعر متناقضة من الفرحة والفخر بالتراث المصري القديم، الذي يعيد صياغة شخصيتنا وإحساسنا بذواتنا كمصريين، ومشاعر أخرى مضادة من الذين يقللون من أهمية الحدث، رافضين التعلق بالماضي وضرورة الانتباه أكثر للحاضر، بكل مشاكله ونواقصه. بالطبع هناك آراء ومشاعر أخرى تتمحور حول الحدث، ربما ليست بالوضوح الكافي للتعبير عن نفسها. ولا يزال السجال دائرًا.
أعتقد أن جميع الاتجاهات والآراء تصب داخل بوتقة هذا الشعور القومي، أيًا كان الموقف من الحدث. وهي لا تخص فقط حدثَ افتتاحِ المتحف الكبير، ولكن علاقتنا بالماضي، ومن أي زاوية ننظر إليه. فالآثار والمتاحف من أشكال تمثيل الذات القومية للمجتمعات، كما يرى المؤرخ بندكت أندرسون. وهي أيضًا من موروثات الماضي، تمامًا مثل الحيز الجغرافي الذي نعيش عليه ويشكل حدود الوطن والهوية.
كلما كان هذا الماضي موغلًا في القدم، ويتجاوز تأثيرُه جغرافيتَّه، كلما أيقظ مشاعرَ عابرةً للزمن، كأن التواصل معه لا يزال قائمًا، والخط مفتوحًا على الدوام بين الماضي والحاضر. فالماضي ليس معطىً ثابتًا، لكنه متغير حسب طريقة النظر إليه، وحسب قدرة الحاضر على التعدد والتأويل، لأن الحاضر أيضًا ليس معطى ثابتًا.
حكايات وحجر
الآثار إحدى صور الماضي في مصر، بعد أن تحوَّل إلى حكايات وحجر وإلهام، وما زال يتحرك كالإرث الذي لا يورث، كونه أحد مقومات صناعة الأمة المصرية في مخيلة أبنائها بتعريف بندكت أندرسون. كما استشهد به المفكر الإنجليزي المتخصص في اقتصاد مصر تيموثي ميتشل في كتابه حول التراث والحداثة، الذي يدور جزؤه الأول عن صناعة السياحة في مدينة الأقصر.
ويشير إلى أن اكتشاف آثار المقبرة الملكية لتوت عنخ آمون عام 1922 على يد هوارد كارتر رافقه فعل من أفعال السيادة المصرية والاستقلال الجزئي عن الاحتلال الإنجليزي ألا وهو إصدار دستور 1923 الليبرالي، كإحدى نتائج هذا الاكتشاف الذي أطلق قوة كامنة داخل هذه الأنا القومية.
يقول في كتابه دراستان حول التراث والحداثة الصادر ضمن مطبوعات مكتبة الأسرة "والحال أن المسعى الأكثر تواصلًا للتذرع بأمجاد مصر القديمة كمصدر للهوية المصرية الحديثة، قد جاء في الربع الثاني من القرن العشرين، على إثر اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في وادي الملوك قرب الأقصر، في عام 1922. فعندما كشف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر عن كنوز أول مقبرة ملكية يتم العثور عليها سالمة في الأزمنة الحديثة، اجتذب الحدث انتباه العالم برمته. وقد حدث الاكتشاف في ذات السنة التي كسبت فيها مصر استقلالًا جزئيًّا عن الاحتلال العسكري البريطاني، وزود الحومة القومية الجديدة بتعبير قوي عن هوية الأمة، غير هذا لم يلعب الماضي الفرعوني غير دور طفيف في النزعة القومية المصرية".
لا يزال هذا الماضي هو المكان الأكثر وضوحًا وتمثيلًا لهذه الروابط والمشاعر بين أفراد المجتمع الواحد، رغم كل عناصر وصور التفكك التي تنتشر في حاضرنا. نادرة هي المناسبات التي أتمثل فيها هذا الإحساس على مستواي الشخصي، وأشعر بانتماء حسي ما مع هذا الماضي، أو جزء منه، وظهور هذه "الأنا القومية"، عندما تجاوز هذا الماضي مكانه، وزمنه، وعكس صورة جديدة عن حاضري/حاضرنا، كمجتمع وحضارة وثقافة إنسانية سبَّاقة في تشكيل قيم العالم الحديث، ونهضته؛ وحجب في طريقه إحساسنا الدائم بدونيتنا وباقتراب الكارثة.
يشير المفكر الهندي البريطاني هومي بابا، أحد المشاركين في تكوين جماعة "دراسات التابع" في كتابه موقع الثقافة، إلى أن الهند شاركت في حداثة إنجلترا، عندما طبقت الأخيرة نظام تقسيم العمل القائم في مصانع النسيج الهندية، بالتالي تكون الحداثة شراكة إنسانية ولا تقتصر على مكان واحد هو الغرب، بل تتسع لأكثر ثقافة، باختلاف درجة تقدمها. وبالقياس، مع الفارق الزمني، ونوع المشاركة. فالماضي المصري القديم كان شريكًا أساسيًا في هذه الحضارة الإنسانية، حتى ولو تغير موقعنا منها اليوم.
القطيعة مع الماضي
طرح شادي عبد السلام في فيلم المومياء: يوم أن تُحصى السنين (1969) قضية العلاقة بالماضي، من خلال صراع بين جيلي الآباء والأبناء. لمن يؤول هذا الإرث الأثري المدفون في جبل القرنة؟ هل هو ميراث يخص قبيلة الحربات التي تعيش في الجبل نفسه، وتتعيش من الاتجار في الآثار، عبر نبش توابيت المومياوات الملكية، وأجسادها ومشغولاتها الذهبية؟ بالطبع كان الجيل الأقدم يؤيد هذا الاتجاه، وعلى النقيض هناك ونيس وأخوه، وآخرون من الجيل الحديث، المتمردون على قيم القبيلة وطريقة عيشها، "التي تعيش عيش الضباع"، يرفضون هذه العلاقة القاصرة مع الماضي، وإرثه، مما يؤدي إلى نبذهما، بل قتل أحدهما.
ونيس الابن الأصغر لشيخ القبيلة الذي توفي حديثًا، وخليفته. كان يحمل تبجيلًا خاصًا لمفتش الآثار ورئيس الأفندية اللذين جاءا من القاهرة للتحقيق في تسريب إحدى البرديات من إحدى المقابر الملكية في الأسواق؛ كونهما يقرآن الكتابات على هذه الأحجار التي قضى طفولته هو وأخوه بين تماثيلها المهمشة، فجعلاها تبدو حية أمامه وليست صامتة، وربما من هذه النقطة بدأ التواصل الإنساني أو الحسي مع هذا الماضي.
حاول ونيس، كروح متمردة حديثة، أن يحرر علاقته بالماضي من الملكية ومن هذا الإرث الدموي، والذنب الذي كان ترتكبه قبيلته بنبش جثث المومياوات. وأيضًا أن يجاوز نسب الدم مع قبيلته باتجاه نسب إنساني أعلى، ومجرد. أُحييَ الماضي ومكوناته بالنسبة إليه، وأصبح حكايةً معرفيةً تنتمي للإنسانية، بحكم هذا الزمن السحيق. فيكشف لمفتش الآثار، بكل أريحية، عن أسرار المقبرة الملكية التي تتعايش عليها قبيلته، مُعرضًا نفسه لخطر الانتقام، ولكنه كان يسعى للتطهر من هذا الذنب لينقذ الماضي الأصلي/المعرفي من الموت. ربما كان لشادي عبد السلام نظرة مقدسة لهذا الماضي، جعلته يتجاوز النظر للسياقات التي كان يتمثل فيها والمجتمعات الفقيرة التي يتفاعل داخلها.
دفن الماضي
أتذكر أن الرئيس السادات كانت له زاوية أخرى للتعبير عن هذه القداسة للماضي، فقد قرر إعادة دفن المومياوات الملكية المعروضة في المتحف المصري إكرامًا لها -وربما لأسباب سياسية ترتبط بحساباته- بدلًا من عرضها في فتارين زجاجية، بعد أن تحول الأثر/الجسد إلى سلعة مهانة. لكنه تراجع بعدها ولم ينفذ هذا القرار بسبب ردود أفعال هذا القرار داخليًا وخارجيًا.
استغربت هذا القرار، ولا أعرف كيف كان سينفذ. كنت قد شاهدت من قبل غرفة المومياوات في الدور الثاني في المتحف المصري، وأحسست بنوع من الرهبة أمام هذه الأجساد العابرة بحاضرنا، كأن هذه المومياوات قد استيقظت في بعث كاذب هو لحظة اكتشافنا لها، وعرضها في الفتارين الزجاجية. فكل هذه الآثار لم تكن موجهة لنا، وهذا الماضي نحن الذي تدخلنا في جريانه لأن حسابات الآخرة لهؤلاء القدماء كانت بريئة، أو غير دقيقة، فأصبحت حياتنا الحديثة، بمثابة الآخرة/البعث لهم.
صون التراث يتطلب تدميره!
تجري وقائع فيلم الجبل للمخرج خليل شوقي (1965)، المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه لفتحي غانم، في الجبل نفسه بالبر الغربي، ويقدم علاقة متعددة الأوجه مع هذا الماضي. هناك المهندس فهمي الذي يريد الحفاظ على التراث المعماري للمكان فيبني قرية جديدة ونموذجية ليُهجَّر إليها أهل البلد لإخلاء الجبل. لكنهم يرفضون، لأنهم يتعيّشون أيضًا من النبش في التوابيت وبيع ذهب القدماء.
هناك تردد من الجيل الجديد المتمثل في حسين الذي مات أبوه بسبب تهدم أحد أنفاق الجبل أثناء الحفر، فأصبح بينه وبين الجبل ثأر شخصي، لن يتركه ويمضي.
تحول هذا الماضي، ليس إلى رابط ولكن إلى سلعة طبقية حديثة، وربما ذابت فكرة الخلود والبعث
في الفيلم صراع جانبي بين المهندس والأميرة التي تمول المشروع، بسبب محاولتها استغلال القرية الجديدة لإقامة الحفلات لها ولأصحابها وخوض علاقاتها الغرامية، ما يتنافى تمامًا مع المعنى والغاية من تأسيس القرية الجديدة. لكن طوال الفيلم، لا يستطيع المهندس مواجهة الأميرة بسبب سلطتها وأنها صاحبة التمويل.
هناك صراع آخر بين حسين ابن القبيلة، والخواجاية التي تريد الحصول على الكنز المدفون في الجبل بمحاولات غوايته، فيستجيب لها حينًا، ثم يتراجع أمام حبه لخطيبته. كان مترددًا بعكس ونيس في فيلم المومياء.
تتماس بقوة حكاية المهندس فهمي في الفيلم مع قصة المهندس حسن فتحي الذي أنشأ عام 1947 قرية القرنة الجديدة بتمويل من إحدى أميرات العائلة المالكة، لكن الأهالي رفضوا التهجير، وأغرقوا القرية، ليرحل حسن فتحي عن المكان دون إكمال مشروعه. في "دراستان في التراث والحداثة"، يقيِّم تيموثي ميتشل دور حسن فتحي والتناقض أو المفارقة التي وقع فيها بسبب هذا الوعي الذي يحركه بالقول: إن صون التراث يتطلب تدميره.
يرى ميتشيل أن حسن فتحي مارس عُنفًا في فرض ذوقه وطريقته في البناء على الأهالي، أملاه موقعه الطبقي الذي ينتمي لكبار الملاك، فهو لكي يحافظ على تراث المكان، الذي هو جزء من الماضي، أراد أن يهدم بيوت الجبل، التي تُشكِّل أيضًا الماضي الحديث بالنسبة للأهالي، ليُقيم قريته النموذجية. وهو ما حدث سنة 2007 بتهجير شامل لأهالي قرى القرنة، لتحويل البر الغربي إلى متحف مفتوح للسياحة.
مكان حدودي
دائمًا الآثار مساحة فاصلة تتصارع داخلها حدود متماسة مع الآخر، الغريب، الأجنبي، أو عملائه، الآتين ليس للاستيلاء على الأرض فقط، ولكن على التاريخ وهذا الماضي، ونسبه لهم. لذا الآثار، بالنسبة لتاريخها، مكان نزاع وظهور هذه "الأنا القومية".
تكوَّنت حول الآثار شبكة عالمية من صناديق الدعم الأجنبية والبعثات ومهربي الآثار العالميين وسماسرته وشركات السياحة سواء للمحافظة عليها بوصفها إرثًا عالميًا، أو استغلالها مصدرًا للثراء. ولكن من ضمن هذا التخطيط الهادف للحفاظ عليها، اقتُرح تهجير أهالي القرنة وتحويل البر الغربي إلى متحف مفتوح، يسهل فيه فصل أهل البلد عن السائح، ليمر داخل أنبوب زجاجي مغلف.
في إحدى مرات زيارتنا للأقصر عام 2008، أقمنا كالعادة في الفندق المقابل لمعبد هابو بالبر الغربي. حوالي التاسعة مساء، جاءت أربعة أوتوبيسات سياحية محملة بنساء يلبسن الفساتين السواريه، ورجال يلبسون الاسموكن، حضروا بطائرات خاصة، وفُتح معبد هابو لهم خصيصًا ليتناولوا فيه طعام العشاء على أنغام موسيقى عمر خيرت.
تحوَّل هذه المعبد الجنائزي الأثري لرمسيس الثالث إلى صالة طعام. وهو ما حدث بأشكال أخرى حديثًا أمام هضبة الأهرام التي أصبحت مكانًا أثيرًا لاستقدام الفرق الأجنبية، ومدى تأثير مكبرات الصوت على الآثار من حولها. يبدو أن قدسية المكان أصبحت مستباحة. تحول هذا الماضي ليس إلى رابط لكن إلى سلعة طبقية حديثة، وربما ذابت فكرة الخلود والبعث داخل هذا الحاضر الاستهلاكي الذي يحوّل كل شيء إلى صورة، كما يقول الفيلسوف الألماني هيدجر، مُعرفًا العالم الحديث.
أيضًا في فيلم "الجبل"، داخل القرية التي بناها المهندس فهمي، وأمام ساحة جامع القرية، أقامت الأميرة حفلة كبيرة، رقصت فيها مع شلتها، كأن السلطة التي تُمثّلها الأميرة تستمد قوتها من العلاقة بهذا الماضي، بالاستيلاء عليه، وتسخيره لنفسها ولمتعتها الشخصية.
مثل ذلك حدث في فيلم ثرثرة فوق النيل للمخرج حسين كمال (1971) عندما يقفز أبطاله السكارى فوق جسد تمثال رمسيس الثاني المستلقي على ظهره في متحف ميت رهينة، وهم يضحكون ويلهون، تظهرهم الكاميرا من أعلى كالنمل أمام هذا الجسد/التاريخ الضخم، إشارة عن انفصال تام عن هذا الماضي.


