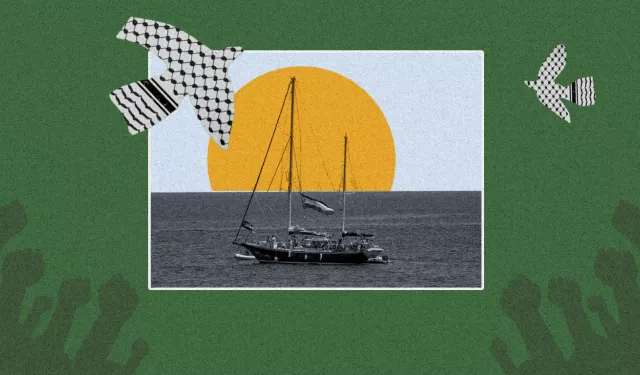
إلى فلسطين| نعم نشعر بالخوف
قبل ساعاتٍ قليلةٍ من كتابةِ هذا النص، تعرَّض قاربُنا للحظةِ فزع حقيقية وكثيفة فجرًا. تعرَّضنا لحادث، لا داعي للدخول في تفاصيله، عرَّض قاربنا وآخرَ للخطر. مرَّ الخطر، واستمرت حالة الفزع والتوتر لبعض الوقت حتى اختفت.
منذ أعلنّا نحن المشاركات والمشاركين في أسطول الصمود انضمامنا لهذه المهمة، والأضواء تتركز علينا كمجموعة كبيرة أو كأفراد. مقابلات، وحوارات، وتصريحات، وريبورتاجات تليفزيونية، وغيرها. كثيرة الأسئلة التي يلقيها الصحفيون علينا، لكن هناك أسئلة ثابتة، من بينها سؤالان؛ لماذا قررت المشاركة؟ ألا تشعر بالخوف؟
السؤال الأول سؤال عن المرجعية، عن الدوافع، عمَّا يحرك كل واحد منَّا ليجعله يشارك في مخاطرة. أما السؤال الثاني فيفترض ضمنيًا أننا بطلات وأبطال لا نشعر بالخوف، فنمتلك بالتالي قدرة الفعل.
في نقاش لاحتمالية تعرضنا لهجوم إسرائيلي قال أحدنا إن من يخافون هم الرجال مفرطو الرجولة
لكن هذا افتراض مبني على مغالطة وعدم معرفة كافية بالحياة والبشر. يتجاهل أنَّ كل البشر -أبطالًا وكومبارسات- يشعرون بالخوف. في الحقيقة تنحصر الفروق في كيفية مراوغة هذا الخوف، ألَّا نجعله يتحكم فينا وفي الأدوات التي نمتلكها، لننجح في مراوغة الخوف ونسيانه، عبر التحكم به.
يعتمد التحكم في الخوف ودرجته على المرجعية؛ مرجعية كل فرد منا التي تدفعه للفعل، للخطر، للمغامرة. من الطبيعي أن تكون لدى أغلبنا نزعة أن نرى أنفسنا أبطالًا متميزين. لكن في هذه الحالة تحديدًا توجد ضرورة أهم من هذه البطولة، ومهمة عاجلة أهم من حماية هؤلاء الأبطال والبطلات الذين يشاركونني هذه المهمة.
هذا الشيء المهم، العاجل، يشترط نزع البطولة عنا، ألَّا نتحول لأبطال يجب حمايتهم. لأن المهمة العاجلة هي وقف الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني في غزة. ألَّا نتصور أننا أبطال وألَّا يرونا متميزين، بل أفراد تحولوا لأدوات ليظلَّ الضوء العالمي مسلطًا على الفلسطينيين.
تفترض المهمة كذلك ألَّا نقع في فخ المقولات التبسيطية مثل تلك التي قالها أحد نجوم الأسطول في أيام التدريب التي سبقت المغادرة، يوم 28 أغسطس/آب، حين سُئِل عن الخوف لحظة اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للأسطول فأجاب بيقينية بأن من يخافون هم الرجال مفرطو الرجولة. وهو التبسيط الذي يلغي شعورًا ضروريًا وطبيعيًا، ليس فقط عند البشر، بل عند كل الكائنات الحية. شعور الخوف.
دموع كارول
قابلت كارول في برشلونة قبل الصعود لقارب يولارا. إنها من هناك، من كتالونيا. عمر كارول وصديقها في حدود منتصف الثلاثينيات. تعمل مهندسة ديكور وهو رجل إطفاء، وكلاهما يفهم جيدًا في القوارب. كانا من ضمن مئات المتطوعين الحاضرين حولنا ليُدعِّموا القافلة بمهام مختلفة. صديقها ممن يشترون الأدوات لإصلاح مشاكل ميكانيكية أو كهربائية في قواربنا. أما هي، فركزت جهودها على شراء احتياجات القوارب من أغذية ومشروبات.
ودعنا كارول وصديقها في ميناء برشلونة. رحلنا، وصلنا تونس، لنجد أنهما طلبا إجازة من عملهما ليستكملا مهمة التطوع في تونس في بلد لا يعرفانه ولا يتكلمان لغته. ولأن منذ اللحظة الأولى التي تعرفت فيها على كارول حدث تواصل كبير بيننا، طلبت مني أن أكون شريكها/مساعدها في مهمة شراء احتياجات القوارب.
كثرة المهام والفوضى وضيق الوقت وغياب طاقة التعاون عند البعض، جعل كارول تبكي بمفردها في جانب مظلم من رصيف الميناء. رأيتها صدفة وجلسنا. حين تنتهي هذه المهمة سأتحدث وأكتب أكثر عن كارول وغيرها. أكتفي الآن وسط ضجيج قارب يولارا والمسافرين فوقه بأن أحكي كيف ترى كارول إبادة الشعب الفلسطيني في غزة وكيف لا تريد نسيانها.
تراقب كارول التهجير المستمر للفلسطينيين. وترى ظلالًا منه في تاريخها الشخصي، وكيف قضت أمها 20 عامًا تدفع ثمن منزل للبنك الدائن لتحمي ابنتيها. وقبل أعوام قليلة تمكن البنك من الاستيلاء على البيت وطرد النساء الثلاثة؛ كارول وأختها وأمها منه. لا تقارن المآسي، تعرف أن مأساتها أصغر بما لا يقارن بما يعيشه الفلسطينيون. لكنها تأخذ من ألمها الشخصي غذاءً للاستمرار في الدعم والمساعدة، في الفعل.
في مواجهة ضوضاء الكاميرات والصحفيين والكلام الذي لا ينتهي والذوات المتضخمة كأبطال، تبحث كارول عن أخبار غزة يوميًا لكي لا تنسى لماذا تفعل كل ذلك. ليس من أجلنا، بل من أجل الفلسطينيين. بكيت وأنا أستمع لكارول بينما هي تبكي تأثرًا. هذا البكاء الناعم الذي عاودني بكثرة مؤخرًا وأفعله سرًا. في فجر أحد الليالي على القارب في عز الظلام وأثناء ورديتي للمراقبة والمساعدة، كنت أبحث من جديد عن مرجعيتي، عمَّا يمنحني هذه الأدوات لمراوغة الخوف ويجعلني أستمر.
لا تشكل معرفتي بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، أو القضية الفلسطينية، أو حركة الدعم لها، أو أخبار غزة، المرجعية النفسية المناسبة لي الآن. أجد المرجعية في مناطق أخرى. في ذاتي كمشاغب ومتمرد، في كل هذا الدعم والاحتفاء من المصريين والعرب. من انتسابي لحركة اليسار المصري وتاريخها النضالي، من ذكرياتي في بيت أهلي المنتمين لليسار ولمصر ولفلسطين منذ الخمسينيات وكيف ربُّونا أنا وإخوتي.
أجد المرجعية في ذكريات الحركة الطلابية المصرية بالنصف الأول من التسعينيات حين كنا نُسجَن سويًا من أجل فلسطين. أحاول استعادة الطاقة الذهنية والنفسية لذاك الوقت وأنا أواجه رحلة قاسية وأستعد لما يمكن أن يحدث وأن أكون قادرًا على مواجهته.
هذه بعض أدواتي، مرجعياتي وكيفية مراوغة خوفي. من بينها أيضًا صور المظاهرات الداعمة لفلسطين في إسبانيا حيث أقيم بشكل أساسي، وفي كل مكان في العالم. ومن ضمنها شعور بأنني عائد لفلسطين ولمن عرفتهم في 2006 حين كنت أصور الفيلم التسجيلي مراجيح هناك. أحاول أن أستعيد زمن البساطة النضالية في النصف الأول من التسعينيات ممزوجًا بأزمنة أخرى تالية وسابقة. أغني الأغاني التي اعتدنا غناءها في فناء جامعة عين شمس، أو في السجن، أو سائرين في شوارع القاهرة ليلًا.
في هذا الفجر المظلم قبل أيام غنيت بعض ما كنا نغنيه، بعض ما كان يغنيه لنا الصديق مصطفى محمد من كلمات الصديق الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، الذي لم أكن أعرفه شخصيًا وقتها. أغنية يا صباح يا أبو قلب نادي. تذكرتها كاملة. أعادتني لما أحتاجه. أعادتني لمرجعيتي ودفء رفاقي القدامى لأراوغ الخوف الحالي.
هذه القصة من ملف إلى فلسطين| نبحر وتبحر قلوبكم معنا
كنا نريدك معنا سيد شابلن
على رصيف في ميناء برشلونة، يوم الأحد 31 أغسطس، حيث يحتشد الآلاف لوداعنا، نحن الصاعدين إلى أسطول الصمود العالمي باتجاه غزة، ربما يفكر البعض مثلما أفكر؛ كنا نريدك معنا يا سيد شابلن.
إلى فلسطين| رسائل البحر
فجأة، لم أصبح بحارًا بل مساعدٌ، أراقب البحر لأتأكد من عدم وجود شيء أمامنا أو قوارب أخرى. وأشد بعض الحبال، وأراعي من أصيبوا بالدوار، وكأن الحلم القديم يتحقق رغمًا عني.
إلى فلسطين| طرق للرحيل وأخرى للعودة
حياة الفلسطينيين محملة برموز القوارب والمسير. وكذلك حياتنا نحن، وحياة المعلقة عيونهم بنا.
إلى فلسطين| من حمام الشط لسيدي بوسعيد
صباح الخير يا تونس، صباح الخير يا فلسطين.
إلى فلسطين| نعم نشعر بالخوف
في هذا الفجر المظلم قبل أيام غنيت أغنية يا صباح يا أبو قلب نادي، فأعادتني لما أحتاجه. أعادتني لمرجعيتي ودفء رفاقي القدامى لأراوغ الخوف الحالي.
إلى فلسطين| من قوارب الموت لقوارب إيقاف الموت
المهاجرون في مراكب الموت يعرفون معنى الاستغلال الرأسمالي القرين بماكينة الموت والجوع في السنغال أو أوروبا أو في أي بلد آخر، التي تُشْهِر أكثر وجوهها توحشًا وفاشية وبربرية في غزة.
إلى فلسطين| لا يدري سلمان أنه يحمل إرث أبيه وجده
التزم محمد بارتداء الكوفية في كل المناسبات والفعاليات، لكنه قبل الصعود للقارب حفظها مع أصدقائه في تونس ووضع حول عنقه كوفية أخرى كي لا يصادر الإسرائيليون كوفية الأب الأنيقة القديمة.
إلى فلسطين| الأيام الأخيرة.. وربما الكتابة الأخيرة
بعد ساعات ربما سنرى سواحل مصر. ربما لن أستطيع الكتابة من جديد. لكن من المؤكد أنني ومحمد البحريني ويوسف الفلسطيني سنغني مرة أخرى أغنية الشيخ إمام ونجم يا مصر قومي وشدي الحيل
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.

